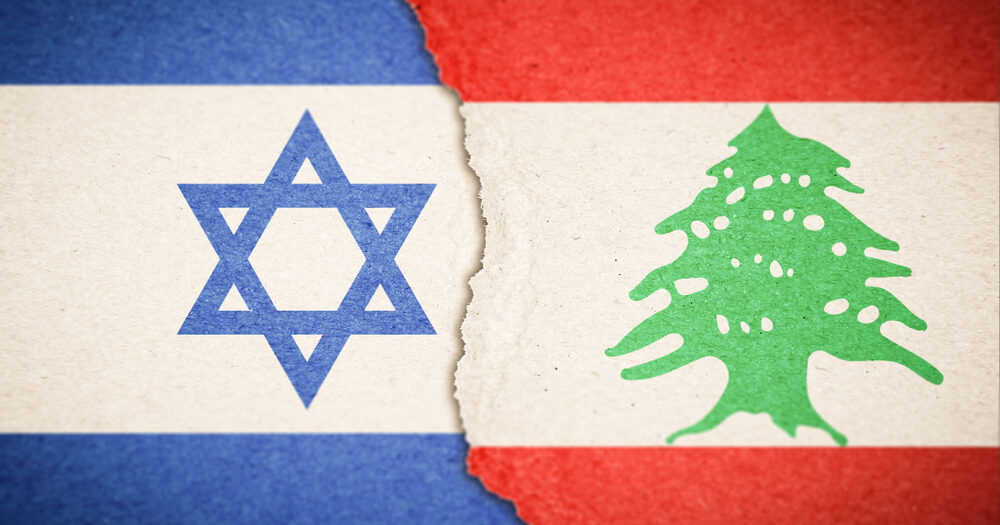بقلم: فارس خشان – النهار العربي
الشرق اليوم – قبل أن تصل سفينة الحفر “اينرجيان باور” من سنغافورة، حيث جرت صناعتها، إلى حقل “كاريش” الغازي الذي ترفض تل أبيب أن يُنازعها لبنان عليه، كان الجيش الإسرائيلي قد أنجز مناورات هي الأوسع من نوعها شهدت نقل وحداته إلى قبرص، حيث حاكى حرباً واسعة مع “حزب الله” في لبنان تتضمّن خطط اجتياح وتطويق، لتضاف، بطبيعة الحال، إلى خطط التدمير المذهلة، وتحضير رأيها العام لما يمكن أن يتكبّده من خسائر بشرية ومادية كبيرة قد تَلحق بالقوى العسكرية كما بالمجتمع المدني.
الأخطر في هذه المناورات لا يكمن في ما تتضمّنه من سيناريوهات، بل في أنّ قبرص التي تربطها علاقات صداقة تاريخية مع لبنان، قدّمت لإسرائيل جغرافيتها حتى تجهّز نفسها لحرب محتملة مع “حزب الله”.
وتشكّل قبرص، وهي عضو في “الاتّحاد الأوروبي”، رمزية مهمّة للمواقف التي يمكن أن تتّخذها، في هذه المرحلة، الدول التي طالما وقفت إلى جانب لبنان ضد الحروب الإسرائيلية عليه.
وهذا يُفيد بأنّ إسرائيل لم تبدأ الخطوات الرامية إلى استخراج الغاز من حقل “كاريش”، إلّا بعدما استكملت استعداداتها العسكرية والدبلوماسية، لخوض الحرب مع “حزب الله” الذي “رذلته” غالبية دول العالم، وتسبّب بـ”عزل” لبنان حتى عن أقرب أصدقائه الإقليميين.
وتنتظر إسرائيل إعلان سلاح البحرية فيها إنهاء استعداداته، بعدما نفّذ المناورات ذات الصلة، في البحر الأحمر، قبل أيّام، حتى تُعطي الضوء الأخضر لبدء العمل على استخراج الغاز من هذا الحقل، بدءاً من أيلول (سبتمبر) المقبل.
من الواضح أنّ إسرائيل لا تستعجل الحرب مع لبنان ولكنّها تتعاطى معها كما لو أنّها واقعة حتماً، على أساس أنّ إيران، وفي ظروفها الأمنية والسياسية والدبلوماسية والاجتماعية والاقتصادية والمالية التي تزداد تفاقماً بسبب إعادة إدخال “الاتفاق النووي” إلى النفق المظلم، قد تجد مصلحة لها في إشعال “حرب بديلة”، من خلال “حزب الله”، إذ تُشكّل خطة استخراج النفط من حقل “كاريش” حجّة حربية لها شعبيتها في لبنان.
في مقابل هذه المخاطر المحسوبة” إسرائيلياً، هل استعدّ لبنان لحرب “فرض النزاع” على حقل “كاريش” الذي بسببه أنهى مفاوضات كانت تتولّاها الأمم المتحدة بحضور الولايات المتحدة الأميركية؟
في الواقع، وعلى الرغم من المدّة الطويلة نسبياً التي توافرت للبنان الرسمي، فإنّ بيروت لم تُحصّن نفسها دبلوماسياً، فهي خرجت من مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، لأنّها حملت مطلباً لم يكن موجوداً على طاولة التفاوض عندما جرت الترتيبات لعقدها، إذ إنّ المطلب اللبناني كان يتمحور حول الخط 23، حيث كان يطالب بـ 860 كيلومتراً مربّعاً، فإذا به يتحوّل إلى الخط 29، حيث راح يطالب بمساحة تصل إلى 2430 كيلومتراً مربّعاً.
وعلى الرغم من إدخال تغيير جذري على مواد المفاوضات، فإنّ لبنان لم يُواكب هذه التغييرات بخطوات ضرورية، من شأنها تحصين موقفه أمام “الشرعية الدولية”، فالوثائق الرسمية المتوافرة في الأمم المتحدة تتضمّن مرسوماً صادراً عن السلطات اللبنانية، تشير فقط إلى نزاع لبناني مع إسرائيل حول الخط 23، فيما الخط 29 الذي تأخّرت مطالبة لبنان به، جاء ضمن رسالة وجّهها إلى الأمم المتحدة، وهي رسالة لا يُمكنها، بالمفهوم القانوني، ومهما كثرت الاجتهادات، أن تُلغي مرسوماً، عملاً بمبدأ “موازاة الصيغ”، حيث المرسوم وحده يُمكنه أن يُلغي مرسوماً موجوداً، في حال جرى الاعتراف بمفعوله الرجعي.
رئيس الجمهورية ميشال عون رفض التوقيع على مرسوم يطالب بحقوق لبنان، بموجب مقتضيات الخط 29، على الرغم من توافره، منذ أيّام حكومة حسّان دياب التي وقّع بعض وزرائها هذا المرسوم، تحت الضغط الذي مورس عليهم، كما ثبت بالنسبة لوزير الأشغال العامة في حينه ميشال نجّار.
ولم تكن تلك الحكومة ترغب في إصدار مرسوم توسيع الحدود البحرية الجنوبية، وتعديل المرسوم 6433، ولكنّها اضطرّت إلى ذلك، خصوصاً بعدما وجّه إليها الفريق الذي وقف وراء تشكيلها، أي “حزب الله”، بواسطة كلّ ما يملك من آلة سياسية ودعائية، اتّهامات “الخيانة”.
وحده رئيس الجمهورية رفض التوقيع، وتالياً تعذّر إصدار المرسوم.
وقد تعرّض عون لاتّهامات كثيرة، ومن بينها أنّه من أجل إنقاذ صهره، رئيس “التيّار الوطني الحر” جبران باسيل من العقوبات الأميركية التي فُرضت عليه، بالاستناد إلى قانون ماغنيتسكي، يرفض التوقيع على مرسوم يغيظ كلّاً من واشنطن وتل أبيب.
قد يكون ذلك صحيحاً وقد لا يكون، ولكن عدم توقيع عون على مرسوم مماثل ليس بالضرورة فعلاً خاطئاً، إذ إنّ رئيس الجمهورية، ومن موقع التواصل الإقليمي والدولي معه، حول المدى الذي يمكن أن تذهب إليه المفاوضات حول المنطقة الاقتصادية الخالصة، قد وجد أنّ الالتزام بالخط 29 في مرسوم، من شأنه أن يُلزم لبنان بعدم التنازل عنه، من دون أن يكرّس له أيّ حق لعلّة “التأخير”، الأمر الذي يغلق، بشكل لا لبس فيه، كلّ أبواب المفاوضات ليفتحها على مواجهات عسكرية وحروب خطرة.
ولكن خطوة عون هذه كان يُفترض أن تُستكمل بإعادة فتح أفق المفاوضات اللبنانية-الإسرائيلية، الأمر الذي لم يحصل لأنّ الوفد المفاوض رفض أن يعود إلى الناقورة من دون الخط 29 في وقت رفضت فيه إسرائيل كلّ بحث في هذه النقطة، لأنّها غير قابلة للتفاوض، من جهة ولا تتّفق مع “تاريخ” المطالب اللبنانية، من جهة ثانية، وهي نتاج لعبة أدارها فريق لبنان غير رسمي، لأنّ مصلحته الحقيقية لا تكمن في ما سوف توفّره آبار الغاز المكتشفة من علاجات للمآزق الاقتصادية والمالية والإجتماعية، بل في خلق “مزارع شبعا” بحرية يضيفها إلى “مزارع شبعا” البرّية، في إطار خلق الأعذار لـ”تأبيد” سلاح “حزب الله” ذي الوظيفة الإيرانية.
ومنذ تلك المحطّة، بدأت إسرائيل تحضّر نفسها فيما راح لبنان يفقد أوراق قوّته.
تل أبيب جهّزت الخطط الإستثماريّة والمالية والبنى التحتية البحرية والبريّة، وأنجزت التحضيرات الدفاعية والهجومية الضرورية، أمّا بيروت فوجدت أنّ شركة “توتال” أوقفت خطط التنقيب عن الغاز في نقطة غير متنازع عليها مع إسرائيل.
لم تُعلن “توتال” عن الأسباب التي دفعتها إلى تجميد الخطوات المتّفق عليها مع لبنان، لكنّ أكثر من مصدر في فرنسا ولبنان أكد أنّ طريقة إدارة النزاع مع إسرائيل حول النقاط المتنازع عليها، من شأنه أن يرفع مخاطر التنقيب إلى مستويات خطرة و”غير إقتصادية”، إذ إنّ مناطق استخراج مصادر الطاقة الطبيعية لا تُحمى بمعادلة الرعب والتهديد التي رفع “حزب الله” لواءها، بل بإعمال مبدأ التفاهم والقبول الذي سقط مع سقوط المفاوضات ذات الصلة بين لبنان واسرائيل.
ومهما كان عليه الأمر، فإنّ كلّ ذلك يُظهر أنّ إسرائيل، ووفق وثائق الأمم المتّحدة الرسمية، تعمل على استخراج النفط من منطقة غير متنازع عليها، بمفهوم القانون الدولي، لأنّ لبنان لم يطالب، وفق القواعد الموجبة وبالتوقيت المطلوب، بهذا الخط.
إذن، وعلى هذا المستوى المهم، لم يحضّر لبنان “المنصة الشرعيّة” لأي حرب يمكن أن يخوضها مع إسرائيل، بحجّة الدفاع عن ثرواته البحرية.
وسوف يكون موقف لبنان أضعف بكثير إذا ما تولّى “حزب الله” خوض هذه الحرب، إنطلاقاً من نظرة غالبية القوى الإقليمية والدولية إليه، على اعتبار أنّه ليس “تنظيماً إرهابياً” فحسب، بل ذراعاً من أذرع “الحرس الثوري الإيراني، أيضاً.
وإذا دخلت إسرائيل أيّ حرب ضد لبنان فإنّ الحزب قد يربح بقدرته على توفير استمراريته، ولكنّ “بلاد الأرز” سوف تخسر، لأنّ تل أبيب لن تقبل بوضع حدّ للحرب التي سوف تخوضها إلّا على قاعدة توفير مصالحها الاستراتيجية.
وفي حرب تموز(يوليو) 2006، أعلن كثيرون أنّ “حزب الله” انتصر، ولكنّ الجميع غضّوا الطرف عن أنّ إسرائيل حقّقت أهدافها الاستراتيجية التي تُرجمت بوصف الوضع على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية، وتحديداً في مناطق النزاع، أي “مزارع شبعا” والجزء اللبناني في بلدة الغجر التي أعيد احتلالها، بأنّها الأكثر هدوءاً في العالم.
وعلى مستوى قدرة الجبهة الداخلية على الصمود، فإنّ إسرائيل، على الرغم من تشظّي واقعها السياسي، إلّا أنّها موحّدة خلف جيشها، في حين أنّ لبنان، على الرغم من شعارات الوحدة والصلابة والمثلّثات، مقسّم في نظرته إلى “حزب الله”.
وفيما إسرائيل تتمتّع بصلابة اقتصادية ومالية، فإنّ لبنان يعيش في واحدة من أسوأ الكوارث العالمية.
إنّ قدرة “حزب الله” على التصدّي عسكرياً لإسرائيل وإلحاق الأذى بها، في أيّ حرب، لا تُغطي عجز الشعب اللبناني عن تحمّل تبعات حرب تدميرية، لا على المستوى المعيشي، بداية ولا على مستوى إعادة الإعمار، لاحقاً.
وبهذا المعنى، فإنّ لبنان نظراً لوضعية “حزب الله” لا يتمتّع، في أيّ مواجهة مع إسرائيل، بالمواصفات التي تتمتّع بها أوكرانيا في وجه روسيا.
ولا يبدو أنّ “حزب الله” يتغاضى، حتى تاريخه، عن هذه الحقائق العسكرية والدبلوماسية والإقتصادية، فهو، ومنذ دخلت سفينة الحفر “اينرجيان باور” إلى حقل “كاريش”، وبغض النظر عن خطابات “رفع المعنويات” جمّد استعمال الأدبيات الحربية.
ولكن ممّا لا شك فيه أنّ الغاز، وقد أصبح “مادة نادرة”، يضيف إلى “البارود” المتراكم في المنطقة، مخاطر إقدام أيّ طرف على إشعال أصغر…فتيل!
 الشرق اليوم اخباري تحليلي
الشرق اليوم اخباري تحليلي