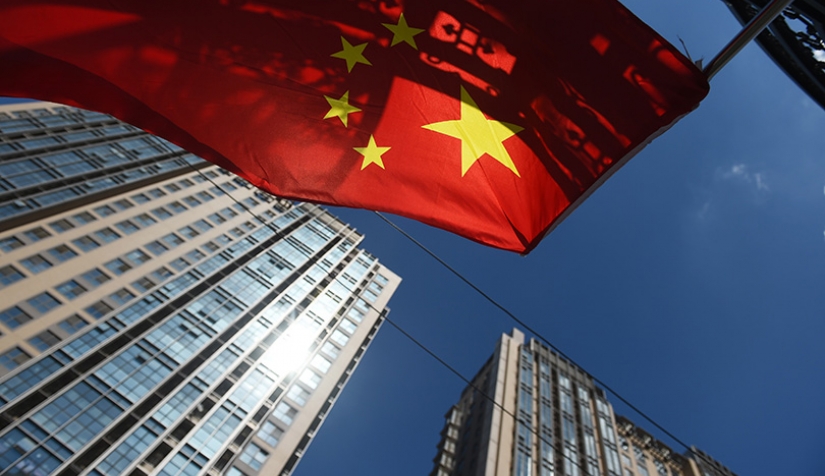بقلم: مايكل بيكلاي وهال براندس – اندبندنت العربية
الشرق اليوم- ثمة إجماع سائد في واشنطن وأماكن أخرى من العالم مفاده أن الصين تندفع قدماً صوب تخطي الولايات المتحدة. في هذا الصدد، أورد الرئيس جو بايدن، “إذا لم نتحرك، فلسوف يلتهمون طعامنا”. كذلك عبر دبلوماسي آسيوي عن الأمر ذاته حين ذكر أن الدول في كل مكان تتحضر للتعامل مع الصين باعتبارها (القوة) “رقم واحد”.
تدعم أدلة كثيرة هذا الرأي. إذ ارتفع الناتج القومي الإجمالي في الصين بـ40 ضعفاً منذ عام 1978. وتتفوق الصين عالمياً في كونها تملك أضخم احتياطات مالية وفائضاً تجارياً، وأكبر اقتصاد بمقياس تكافؤ القدرة الشرائية، وأوسع قوة بحرية عالمية في عدد السفن. وفيما أصداء الانسحاب الأمريكي المذل من أفغانستان ما زالت تتردد، تتقدم الصين هادرة لصوغ قارة آسيوية متمحورة حولها، والحلول مكان واشنطن في قمة الهرمية العالمية.
في المقابل، يتمثل ما يجعل الصين على عجلة من أمرها اليوم في أن صعودها شارف تقريباً على الانتهاء. إذ إن وجهة صعود الصين طوال العقود العديدة الماضية دعمته تيارات رياح قوية، لكن هذه الأخيرة باتت الآن تهب من الجهة المعاكسة. وفي السياق نفسه، تخفي الحكومة الصينية في الوقت الراهن تباطؤاً اقتصادياً خطيراً، وكذلك تنزلق عائدة إلى نظام شمولي جامد. وتواجه البلاد شحاً حاداً في المصادر، وانهياراً ديموغرافياً في فترة السلم يعد الأسوأ في تاريخها. ويمكن أن نذكر على الأقل في هذا الصدد، أن الصين تخسر الطريق الذي قادها إلى عالم مُرَحِّبٍ بها، وأتاح لها تحقيق التقدم.
أهلاً بكم في عصر “ذروة الصين”. إنّ بكين قوة تغييرية قديرة تريد إعادة صوغ العالم، إلا أن فرصتها في تحقيق ذلك باتت في آخرها فعلياً. لكن، ينبغي ألّا يدفع ذلك الأمر واشنطن إلى التساهل والاطمئنان، بل إلى عكس ذلك. فكثيراً ما تنحو القوى التي عاشت حالة نهوض، نحو العدائية حينما تخبو حظوظها ويتكاثر أعداؤها. تسلك الصين اليوم منحنًى ينتهي بمأساة، بمعنى حدوث صعود مذهل، يعقبه شبح سقوط عنيف.
صناعة المعجزة
عاشت الصين حالة صعود على مدى فترة طويلة، ما جعل مراقبين كثراً يعتقدون أن تصدرها سدّة العالم سيكون محتوماً. وفي الحقيقة، إن العقود القليلة الماضية في كنف السلام والازدهار تمثل، من الناحية التاريخية، حالة شاذة ولدتها ظروف عابرة.
لقد تمتعت الصين بدايةً ببيئة جيوسياسية آمنة عموماً، وبعلاقات طيبة مع الولايات المتحدة. وكذلك أدى موقع الصين الحساس عند تقاطع أوراسيا ومنطقة المحيط الهادئ، إلى جعلها محكومة بالنزاعات والمصاعب في معظم حقب تاريخها الحديث. ومن “حرب الأفيون الأولى” عام 1839، إلى نهاية “الحرب الأهلية الصينية” عام 1949، عملت القوى الإمبريالية على تمزيق الأرض الصينية وتقطيعها. وبعد أن توحّدت الصين تحت الحكم الشيوعي في 1949، واجهت عدائية شديدة من قبل الولايات المتحدة، وكابدت أيضاً عداء القوتين العظميين آنذاك (الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي) إثر انهيار التحالف الصيني– السوفياتي في ستينيات القرن العشرين. بالتالي، ظلت الصين معزولة ومحاصرة بالفقر والشقاق.
ثم جاء الانفتاح على الولايات المتحدة عام 1971 ليكسر ذاك الواقع. وفجأة، صار لبكين حليف هو قوة عظمى. وفي ذلك الإطار، وجّهت واشنطن تحذيراً إلى موسكو من مغبة مهاجمة الصين، وسرّعَتْ أيضاً إدخال الأخيرة إلى النادي العالمي الواسع. ومع حلول منتصف السبعينيات من القرن العشرين، باتت الصين بلداً آمناً، فانفتحت أمامها السبل للوصول إلى الأسواق الأجنبية ورؤوس الأموال، في توقيت مثالي. إذ إن التجارة العالمية نمت بمعدل ستة أضعاف بين العامين 1970 و2007. وفي تلك الأجواء، امتطت الصين زخم العولمة، وغدت ورشة عمل العالم.
وكذلك استطاعت الصين تحقيق تقدمها لأن حكومتها التزمت عموماً بالإصلاح. فبعد رحيل ماو تسي تونغ عام 1976، وضع “الحزب الشيوعي الصيني” حدوداً لفترات تولي الرئاسة، وقيوداً وضوابط أخرى أمام القياديين. وراح الأمر ينعكس إيجاباً على الكفاءات التكنوقراطية والأداء الاقتصادي الجيد. وأتاح لسكان الأرياف أيضاً الشروع في مشاريع استثمارية مخفّفة القيود. وانتشرت المناطق الاقتصادية الخاصة في أنحاء البلاد، ما سمح للشركات الأجنبية بإجراء عملياتها في أجواء من الحرية. وتمهيداً لانضمامها إلى “منظمة التجارة العالمية” في 2001، تبنّت بكين أنظمة قانونية وضرائبية حديثة. وبذا، امتلكت الصين سلّة سياسات مناسبة أسهمت في نجاحها وازدهارها ضمن عالم مفتوح.
كذلك تمتعت الصين بطبيعة سكانية مناسبة. إذ حققت المكاسب والحصص الديموغرافية الأعظم في التاريخ الحديث، والتي قدرت بـ”عشرة بالغين في عمر العمل” لكل مواطن متقدم في السن. ولا يتخطى هذا الرقم الخَمسَة (أي “خمسة بالغين في عمر العمل” لكل مواطن مسن) في معظم الاقتصادات الأساسية في العالم.
لقد شكّلت تلك المكاسب الديموغرافية نتيجة محظوظة تأتت من تذبذبات عنيفة في السياسات المتبعة. ففي خمسينيات القرن العشرين وستينياته، شجع “الحزب الشيوعي الصيني” النساء على إنجاب عديد من الأطفال لزيادة عدد السكان بعد مقتلات الحروب والقحط. وخلال 30 سنة، ارتفع عدد السكان بـ80 في المئة. لكن، في أواخر السبعينيات، داست الصين على المكابح، وألزمت كل عائلة بإنجاب طفل واحد. نتيجة لذلك، حازت للصين في تسعينيات القرن العشرين والسنوات الأولى في القرن 21، قوى عاملة ضخمة مقابل عدد قليل نسبياً من المسنين والأطفال المحتاجين إلى العناية. ولم تتمتع أي شريحة سكانية مِن قَبْل في العالم بهكذا وضعية مناسبة لرفع مظاهر الانتاجية. ولم تحتاج الصين إلى مساعدة خارجية كبيرة في إمداد مواطنيها بالغذاء والماء، وصناعاتها بمعظم المواد الخام الأولية. إذ إن سهولة الوصول إلى تلك المصادر، معطوفة على رخص الأيدي العاملة وضعف الضوابط البيئية، جعلت من الصين مركزاً للصناعات.
تراجع الثروات
بيد أن الطفرات التي تحدث مرة واحدة في كل حقبة، لا تدوم إلى الأبد. إذ إن الميزات التي ساعدت الصين في النهوض غدت خلال العقد الفائت نقاط ضعف نزولاً. فالصين، بالنسبة لرواد المشاريع، باتت تستهلك مصادرها. لقد نضبت نصف أنهارها واختفت، وأصاب التلوث ما يزيد على 60 في المئة من مياهها الجوفية، ما يعتبر، وفق إقرار الحكومة الصينية، “غير ملائم لأن يلامسه البشر”. وكذلك جعل التقدم الفائق من الصين أكبر مستورد في العالم للطاقة الصافية. وفي الإطار ذاته، يشهد الأمن الغذائي تهافتاً أيضاً. لقد دمرت الصين 40 في المئة من حقولها الزراعية بسبب الاستخدام المفرط، وغدت أكبر مستورد في العالم للمنتجات الزراعية. وبات النمو مكلفاً جداً، ويعود ذلك في جزء منه إلى ضآلة المصادر، إذ يتوجّب على الصين استثمار رأس مال أكبر بمعدل ثلاث مرات بغية توليد معدل نمو يماثل ما تحقق في السنوات الأولى من القرن الجاري. ويمثل ذلك الأمر الأخير زيادة أكبر بكثير مما يتوقعه المرء إزاء أي اقتصاد في مرحلة النضوج.
ويضاف إلى ذلك أن سكان الصين يتضاءلون بفعل إرث سياسة “الطفل الواحد”. بين العامين 2020 و2035، ستفقد الصين ما يقارب 70 مليون نسمة من البالغين الذين هم في سن العمل، وستكسب 130 مليون نسمة من المسنين. وتوازي الشريحة الأولى التي ستخسرها عدد المستهلكين ودافعي الضرائب والعمال في فرنسا، فيما توازي الثانية، [العدد الإضافي من المسنين]، عدد المتقاعدين في اليابان خلال 15 سنة. وبين 2020 و2050، ستفقد الصين 105 ملايين نسمة إضافية من العمال، وستكسب 65 مليون نسمة إضافية من المسنين. وستكون تبعات هذا الأمر على الاقتصاد مريعة. إذ تشير التوقعات الراهنة إلى أن الإنفاق المرتبط بمعدلات الأعمار ينبغي أن يزداد بثلاثة أضعاف مع حلول عام 2050، فيرتفع من 10 في المئة إلى 30 في المئة من الناتج الإجمالي المحلي. ولتوضيح الأمر، نذكر أن مجمل إنفاق الحكومة الصينية اليوم يبلغ نحو 30 في المئة من الناتج الإجمالي المحلي.
بالتالي، سيكون التعامل مع جميع هذه المشكلات صعباً على نحو خاص، لأن الصين اليوم يحكمها دكتاتور يستمر في التضحية بالكفاءة الاقتصادية من أجل السلطة السياسية. وقد باتت الشركات الخاصة التي ولدت معظم ثروات البلاد تحت حكم الرئيس شي جينبينع، محرومة من رؤوس الأموال. وفي المقابل، تتلقى الشركات غير الكفوءة التي تملكها الدولة 80 في المئة من القروض والإعانات الحكومية. وأصاب الانتكاس ذلك الازدهار الصيني الذي تصدره رواد المشاريع المحليون. إذ أدّت حملة مكافحة الفساد التي أطلقها الرئيس شي، إلى إخافة الرواد المحليين وكبحهم من الانخراط في تجارب ومغامرات اقتصادية. وبشكل أساسي، حظرت حكومة الرئيس شي، الأخبار الاقتصادية السلبية، ما جعل أمر الإصلاحات الذكية مهمة مستحيلة تقريباً. وقد أدّت موجة التدابير والقيود ذات النوازع السياسية، إلى سحق حركة الإبداع. وإزاء توجّه الصين إلى مزيد من السلطوية والسياسات المتشددة، تراجع دور العالم وفعله وتضاءلت مساهمته في النمو الصيني. بالتالي، تواجه بكين الآلاف من العوائق التجارية الجديدة منذ الأزمة المالية في 2008، إثر لجوء معظم اقتصادات العالم الكبرى إلى حماية شبكات اتصالاتها من التأثير الصيني. في السياق ذاته، تتطلع أستراليا والهند واليابان وغيرها من الدول إلى استثناء الصين من سلاسل إمداداتها.
مأزق اقتصادي
مع نهاية إجازتها من التاريخ التي دامت أربعة عقود، غدت الصين الآن أمام اتجاهين يتمثلان في تباطؤ النمو والطوق الاستراتيجي الذي تواجهه، بالتالي، فإن ذلك ينبئ بنهاية صعودها. وقد دخل الاقتصاد الصيني نتيجة مشكلاته المتراكمة، في أطول مرحلة تباطؤ لحقبة ما بعد ماو تسي تونغ. فتراجع معدل الناتج الإجمالي المحلي الرسمي من 15 في المئة عام 2007 إلى 6 في المئة عام 2019، وجاء ذلك قبل أن تؤدي جائحة كورونا إلى تقليص المعدل المذكور ليغدو أعلى قليلاً من 2 في المئة عام 2020. حتى أن هذه المعطيات والأرقام مبالغ بها. إذ تظهر دراسات معمقة ودقيقة أن النمو الفعلي في الصين ربما لا يتجاوز إلا بقليل، نصف الأرقام التي تنشرها الحكومة.
واستطراداً، يتمثل الأسوأ من ذلك كله في أن معظم نمو الصين منذ 2008 جاء نتيجة ما ضخته الحكومة في اقتصاد البلاد من رأس مال قسري. إذا طرحنا من تلك المعادلة ما تنفقه الحكومة على تحفيز النمو، فسيظهر أن لا نمو في الاقتصاد الصيني كله. كذلك فإن الانتاجية التي تمثل مكوناً أساسياً في عملية خلق الثروة، تراجع معدلها بنسبة عشرة في المئة بين العامين 2010 و2019، ويشكّل ذلك التراجع الأكبر بالنسبة إلى قوة عظمى، منذ أيام الاتحاد السوفياتي في ثمانينيات القرن 20.
واستطراداً، من المستطاع معاينة دلائل وبيانات تصاعد ذلك العقم في المجالات كلها. وتملك الصين اليوم أكثر من 50 “مدينة أشباح”، أي مراكز حضرية تضم طرقاً سريعة ومساكن، لكنها خالية من الناس. ولن تستطيع قرابة ثلثي مشاريع الصين في البنى التحتية، تعويض تكاليف إنشائها أبداً. وتتبدى النتيجة البديهية لهذا الأمر عبر مديونية لا يمكن السيطرة عليها. وقد قفز الدين العام الصيني بين العامين 2008 و2019 بثمانية أضعاف. نحن نعرف إلى أين تؤدي هذه الحال، بمعنى أنه يوصل إلى ظهور فقاعات استثمارية تقود إلى حالة كساد مديدة. في اليابان أدّت المبالغة في منح القروض أثناء ثمانينيات القرن العشرين إلى ثلاثة “عقود ضائعة” عانت معدلات نمو طفيفة. في الولايات المتحدة أدى الأمر نفسه إلى التباطؤ العظيم [الأزمة المالية في 2008]. وإذا أخذنا حجم جبل الدين الصيني اليوم في الاعتبار، فستكون التبعات أسوأ. وببساطة، قد تكون المشكلات الراهنة التي تعاني منها شركة التطوير العقاري الصينية “إيفرغراند” Evergrande الرازحة تحت دين هائل، إشارة إلى أشياء ستحصل.
بيد أن الحزب [الشيوعي الصيني] لا يقر بالهزيمة. ويأمل الرئيس شي بإعادة النمو المتسارع عبر الابتكارات التكنولوجية، فرفع الإنفاق على “البحوث والتطوير” بثلاثة أضعاف منذ عام 2006. لكن الجهود المذكورة أخفقت في تنشيط الانتاجية. وما زالت أسهم الصين ضئيلة في الأسواق العالمية في معظم قطاعات صناعة التكنولوجيا الفائقة. ويعود السبب الأساسي في ذلك إلى أن نظام “البحوث والتطوير” الصيني، من القمة إلى القاعدة، على الرغم من فعاليته الشديدة في حشد الموارد، يخنق التدفق المفتوح للمعلومات وموارد رأس المال الضرورية في استدامة طاقة الابتكار. ولن تؤدي حملة الضغوط السياسية الراهنة الهادفة إلى إرساء الامتثال الثقافي، لسوى تعقيد الأزمة.
ومثلاً، أنفقت بكين عشرات مليارات الدولارات على القطاع المحلي في صناعة الرقائق الالكترونية الدقيقة، بيد أنها ما زالت تعتمد على استيراد 80 في المئة من حاجة البلاد للقطع المتعلقة بأجهزة الكمبيوتر. كذلك بددت الصين عشرات مليارات الدولارات في التكنولوجيا الحيوية، إلا أن اللقاحات المضادة لـ”كوفيد- 19″ التي أنتجتها لا يمكنها منافسة اللقاحات المنتجة في الدول الديموقراطية. واستكمالاً، لن ينقذ الابتكار الصين من تباطؤ النمو. ولسوف يزعزع ذلك الكساد نظامها، فيما يشتد التهديد الآخر، المتمثل بالطوق الاستراتيجي المضروب حولها.
حلقة نار
طالما مثلت أوراسيا فخاً قاتلاً للطامحين إلى الهيمنة فيها. فالأعداء هناك كثر جداً، ويمكن لكل منهم الالتقاء حول قضية مشتركة مع قوى عظمى عبر البحار. وطوال 40 سنة تقريباً، عملت الصين الصاعدة على تجنب الحصار الاستراتيجي عبر التقليل من طموحاتها العالمية والمحافظة على علاقات طيبة مع الولايات المتحدة. لكن هذه الفترة انقضت. ومع تصاعد عدائية بكين في بحر جنوب الصين ومضيق تايوان ومناطق أخرى، تبلورت مواقف عدائية مقابلة لها في كل أنحاء العالم تقريباً.
وفي المقابل، على مدى السنوات الخمس الماضية، تخلّت الولايات المتحدة عن سياسة التعاون مع الصين، وتبنت سياسة احتواء جديدة. وحققت واشنطن التوسع الأكبر خلال جيل كامل في حقل القوى البحرية والصاروخية، فارضة التعريفات الجمركية الأكثر تشدداً منذ الحرب العالمية الثانية. كذلك طبّق الأميركيون القيود الأقسى منذ “الحرب الباردة” [الصراع بين الاتحاد السوفياتي السابق وأميركا خلال معظم القرن العشرين] على الاستثمارات الأجنبية التي تعلقت كلها بالاستثمارات الصينية. كذلك ازدادت مبيعات الأسلحة ومظاهر الدعم العسكري لدول المواجهة. وتهدد العقوبات الأميركية في هذا الإطار بتدمير شركة “هواوي” وغيرها من الشركات الصينية. وفي 2021، اشتكى نائب وزير الخارجية الصيني من أن “الحملة الحكومية والمجتمعية الشاملة (هذه)، جُرِّدَتْ بهدف إسقاط الصين”.
وفي السياق نفسه، ولّد انتقال الولايات المتحدة إلى معاداة الصين، ردود أفعال قاسية أشد اتساعاً ضد نفوذ بكين. ففي شمال شرقي آسيا غدت تايوان مصممة، أكثر من أي وقت مضى، على صون استقلالها الفعلي. وفي ذلك الإطار، أقرّت الحكومة التايوانية استراتيجية دفاعية جديدة وجريئة يمكنها أن تجعل غزو هذه الجزيرة أمراً بالغ الصعوبة. كذلك وافقت اليابان على التعاون الوثيق مع واشنطن لصد عدائية الصين في المنطقة. ويمكن القول إن بكين، من خلال عدوانيتها، جعلت التحالف الأمريكي- الياباني يغدو بوضوح، حلفاً معادياً للصين.
في الإطار ذاته، بدأت الدول المحيطة ببحر جنوب الصين في التلاقي حول مسألة مواجهة بكين. ومثلاً، شرعت فيتنام في الحصول على صواريخ متحركة تطلق من السواحل، وغواصات هجومية روسية وطائرات حربية جديدة وسفن مجهزة بصواريخ “كروز” متطورة. وشيئاً فشيئاً، غدت سنغافورة شريكاً عسكرياً للولايات المتحدة. كذلك زادت إندونيسيا إنفاقها العسكري عام 2020 بـ20 في المئة، ورفعته إلى 21 في المئة عام 2021. حتى الفيليبين التي توددت إلى الصين في معظم فترة رئاسة رودريغو دوتيرتي، تعمد اليوم إلى تكرار وتأكيد مزاعمها في بحر جنوب الصين، وتكثف دورياتها الجوية والبحرية في المنطقة.
وتستثير طموحات الصين أيضاً ردود فعل تتجاوز منطقة شرق آسيا، فتبلغ أستراليا والهند وصولاً إلى أوروبا. وفي كل اتجاه تخوضه الصين وتلقي بثقلها فيه، تلقى دفعاً مضاداً متصاعداً من قبل منافسيها. في هذا الإطار، جاء ظهور “اللقاء الأمني الرباعي” The Quadrilateral Security Dialogue، الشراكة الاستراتيجية التي تضم أستراليا والهند واليابان والولايات المتحدة، ليشكل محوراً أساسياً في تعاون القوى الديمقراطية الأكبر ضمن منطقة المحيطين الهندي والهادئ في مواجهة الصين. كذلك يعمل حلف “أوكوس” AUKUS (أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة) على توحيد عمق الفضاء الأنجلوفوني [أنجلوسفير Anglosphere] بمواجهة بكين. وتعمل الولايات المتحدة على صياغة تحالفات صغيرة متداخلة تضمن من خلالها بقاء الدول الديمقراطية المتقدمة متفوقة في مجال التكنولوجيا الأساسية. كذلك تدرس “مجموعة الدول السبع” وحلف الناتو إمكانية اعتماد مواقف أقوى (بمواجهة الصين) في مسألة تايوان وغيرها من القضايا. وللدقة، من المستطاع في تلك النقطة الإشارة إلى أن التعاون في مواجهة الصين يبقى عملاً في طور الإنجاز، لأن دولاً كثيرة ما زالت تعتمد في تجارتها على الصين. في نهاية المطاف، تستطيع تلك الشراكات المتداخلة والمتشابكة أن تشكّل خناقاً حول عنق بكين.
نجم يخبو
الصين قوةٌ نهضت وليست قوة ناهضة. وقد اكتسبت قدرات جيوسياسية هائلة، بيد أن أفضل أيامها باتت وراءها. هذا الفارق في التوصيف مهم، لأن الصين سعت إلى طموحات كبيرة جداً وقد تكون اليوم عاجزة عن تحقيقها من دون اللجوء إلى عمل جذري. في هذا الإطار، يتطلع “الحزب الشيوعي الصيني” إلى استرجاع تايوان والسيطرة على منطقة غرب المحيط الهادئ وبسط نفوذه حول العالم. وفي هذا السياق، أعلن الرئيس شي أن الصين تسعى إلى “مستقبل تكون فيه بموقع المبادرة وتحظى بمركز مهيمن”. في المقابل، إنّ ذلك الحلم بدأ يخبو، فيما يتباطأ النمو وتواجه الصين عالماً يزداد عدائية. قد يمثل الأمر أخباراً جيدة بالنسبة إلى واشنطن. إذ إن حظوظ الصين في تجاوز الولايات المتحدة بسهولة باتت ضئيلة. إلا أن الحال ليست محسومة تماماً. فمع بروز مشكلات الصين، قد يبدو المستقبل خطراً بالنسبة لبكين، وسيخيم شبح الركود على قادة “الحزب الشيوعي الصيني” وسوف يتساءل شي جينبينع إن كان بوسعه تحقيق وعوده الكبرى. إنها اللحظة التي ينبغي فيها على العالم أن يقلق.
إذ تميل القوى التغييرية إلى أن تغدو غاية في الخطورة حين يظهر أن الهوّة بين طموحاتها وقدراتها، غير قابلة للإدارة. وحين تبدأ النافذة الاستراتيجية بالإنغلاق أمام قوة عظمى مستاءة، فإن مجرد احتمال ضئيل بتحقيق نصر هجومي قد يبدو لها أفضل من سقوطٍ مذل. وإذ يخشى القادة التسلطيون من أن يؤدي التراجع الجيوسياسي إلى تقويض مشروعيتهم السياسية، يستحوذ اليأس عليهم غالباً. يأتي المثل على ذلك من ألمانيا حين أعلنت الحرب العالمية الأولى كي تحول دون تمكُّن القوى المؤتلفة، البريطانية – الروسية – الفرنسية، من سحق طموحاتها في الهيمنة. كذلك بدأت اليابان الحرب العالمية الثانية في الجبهة الآسيوية كي تحول دون قيام الولايات المتحدة بكبح نفوذها الإمبراطوري.
وحاضراً، تفتح الصين وتُراجِع محتوى عدد من الصناديق المقلقة. تباطؤ النمو؟ حسناً. الطوق الاستراتيجي؟ حسناً. نظام سلطوي وحشي ومصادر قليلة من المشروعية العضوية؟ حسناً. فأس تاريخي للجز وطموحات ثأرية؟ حسناً وحسناً. في الحقيقة، لقد باتت الصين منخرطة فعلياً في ممارسات متوقعة من بلد في موقعها، بمعنى اللجوء إلى تعزيز القوى العسكرية، والبحث عن مناطق نفوذ في آسيا وخارجها، ومضاعفة جهود التحكم في التكنولوجيات والمصادر الحساسة. وإذا كانت هناك معادلة تعبّر عن موقف عدائي تتخذه قوة في موقع الذروة، فإن الصين تقدّم اليوم العنصر الأساسي في تلك المعادلة.
يرى مراقبون عديدون أن الصين تعمل راهناً على توزيع ثقلها هنا وهناك لأنها شديدة الثقة في استمرار صعودها. وبالتأكيد، بدا الرئيس شي مقتنعاً بأن جائحة كورونا والاضطراب السياسي في الولايات المتحدة خلقا لبلاده إمكانيات جديدة في التقدم. بيد أن الاحتمال الأكثر ترجيحاً، والأكثر رعباً، يتمثل بعزم القادة الصينيين على التحرك سريعاً لأن وقتهم ينفد. ماذا يحدث حينما يستنتج بلد يريد إعادة صوغ العالم أن هدفه ذاك لن يحصل سلمياً؟ جواب التاريخ والتصرفات الصينية اليوم على هذا السؤال، يتمثّل في أنه سيفعل أشياء لا خير فيها.
 الشرق اليوم اخباري تحليلي
الشرق اليوم اخباري تحليلي