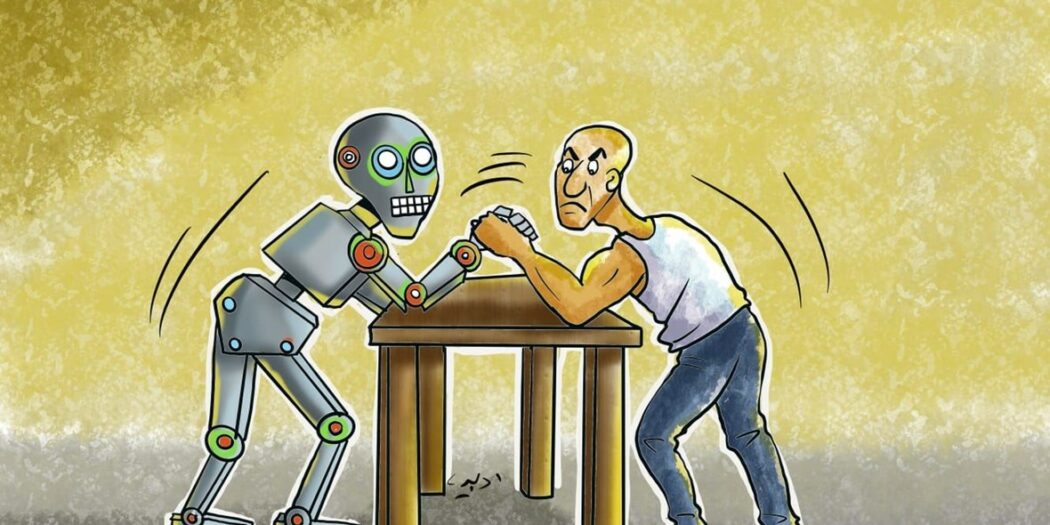بقلم: حسن إسميك – النهار العربي
الشرق اليوم – اختلال في الذاكرة الرقمية لست ساعات فقط، كان كفيلاً بإيقاف العالم كله. هذا ما حدث عندما توقف تطبيق فايسبوك وعائلته، واتساب وإنستغرام، عن العمل مساء الاثنين 4 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. كيف لا والتطبيق يستخدمه مليارات من البشر! والذين لا يخشى أكثرهم من التأثير الذي تحمله تكنولوجيا “التواصل الاجتماعي”، رغم ما لها من خطورة متعددة الجوانب والأبعاد، ويخشون الذكاء الاصطناعي وكأنه الخطر الذي يتهدد مستقبل بقاء البشرية!
تتطلع البشرية إلى الروبوتات عموماً، وإلى تلك التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي خصوصاً، بعين التفاؤل والريبة في آن معاً. فهي من جهة، تقدم لنا كفاءة وسرعة وإنتاجية أعلى، ما يسهل لنا الحصول على ما نريد من خدمات بسرعة ودقة أكبر، ومن جهة أخرى هناك مخاوف من أن تصبح بديلاً عن البشر في سوق العمل نتيجة التطور السريع الذي نشهده اليوم، فقد أصبح الروبوت يعمل جنباً إلى جنب مع الإنسان في كثير من المجالات، ما يعني أننا مع كل تقدم تكنولوجي في مجال ما، نجد أنفسنا أمام فقدان شريحة من الوظائف التي يخسرها عمال من لحم ودم لمصلحة العمال الافتراضيين الجدد.
توضح دراسة إحصائية أجريت عام 2020 أن هناك 2.4 مليوني روبوت اصطناعي تعمل في المصانع اليوم في مختلف أنحاء العالم. ويقدم لنا تقريرٌ صادر عن “منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD” أرقاماً صادمة، توضح أن نحو 14 في المئة من فرص العمل “مهددة بالزوال” بحسب تعبير المنظمة، و32 في المئة من فرص العمل ستشهد تحولاً جذرياً. لكن إذا كنا سننظر إلى كل تكنولوجيا على أنها خطر محدق بفرص العمل ولا يجب تطويرها، فعلينا السؤال أيضاً عن كم فرص العمل والمهن التي اختفت تاريخياً، ونظيراتها التي ظهرت مواكبة للتطور.
يقول الباحث كيفين روز في كتابه “برهان المستقبل” إن على الإنسان التركيز على تحصين مهنته عبر سؤال “ما الوظيفة التي يؤديها الإنسان أفضل من الروبوت؟” ولعل قدرتنا نحن البشر على التواصل هي إحدى الميزات البديهية التي ما زال أمام الروبوتات أشواط ومراحل طويلة لتتمكن من الوصول إليها. وبحسب الإحصاءات، إن أقل المهن تضرراً من ثورة الذكاء الاصطناعي هي تلك التي تعتمد على التواصل وليس التوصيل، كالإختصاصيين النفسيين مثلاً أو المعلمين أو المهن الفنية، وغيرها من الأعمال التي تتطلب “لمسة بشرية”.
ولعلّ أهم سمة تميزنا كبشر عن سائر الكائنات هي قدرتنا على الإبداع والابتكار، وهي التي جعلت منا مخترعين ومؤلفين وفنانين قادرين على بناء الحضارة وتطويرها. لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو كيف ننقل تلك القدرة إلى الروبوتات؟ وما الفائدة من ذلك؟
قامت أبحاث عديدة في العقد الأخير بقفزات نوعية في مجال جعل الروبوت قادراً على الإبداع. فقد قام باحثون في معهد جورجيا في الولايات المتحدة بتطوير روبوت قادر على تأليف الموسيقى وعزفها. وهناك منصة “أمبر Amper” على الإنترنت، والتي تتيح لك الطلب من الذكاء الاصطناعي تأليف موسيقى خاصة لك. كما طور باحثون من معهد كولورادو منظومة ذكاء اصطناعي قادرة على نظم الشعر بعد قيامها بمعالجة آلاف النصوص الشعرية والأدبية!
قد يرى بعضنا في ذلك تهديداً، لكنني، وعلى العكس، أرى أن الروبوت سيكون مساعداً رائعاً للإنسان، وليس منافساً بالضرورة، فسرعته العالية في معالجة البيانات والمعلومات الضخمة ستوفر وقتاً وجهداً كبيرين، ومهما بلغت قدرة الروبوت على الابتكار ستظل محكومة بتنظيم معين، بينما قدرة الإنسان على الابتكار والإبداع تؤثر فيها “عشوائية وعبثية” أفكاره المنظمة منها وغير المنظمة، ما يجعل العلاقة بين الإنسان والروبوت علاقة تكامل بين مبتكر ومساعد لا علاقة الند بالند.
في هذا السياق، وعند الحديث عن قيام علاقة بين الإنسان والروبوت، وعن مستقبل ستوجد فيه الروبوتات جنباً إلى جنب مع الإنسان، فنحن هنا أمام تجربة إنسانية لم يشهد لها التاريخ البشري مثيلاً. فما هو شكل الحياة التي ستكون الآلة جزءاً لا يتجزأ منها؟ وهل نحن أمام أنسنة للآلة أم رقمنة للإنسان؟
لمقاربة هذا السؤال، جرت وتجري محاولات علمية كثيرة لإدماج المشاعر الإنسانية في الآلة، وذلك بهدف جعلها قادرة على التعاطف مع البشر أو حتى اتخاذ قرارات أخلاقية، ففي عام 2020 تمكن علماء يابانيون في جامعة أوساكا من بناء روبوت قادر على الشعور بالألم مبرمج للفرار عند تطبيق شحنة كهربائية على جلده الاصطناعي واختباره، وذلك بهدف تحسين تعاطف الروبوت مع البشر. وتعليقاً منه على التجربة، قال هيتاشي ايشيهارا، أحد العلماء المشاركين: “إن التعاطف والخصائص الانسانية أمران حاسمان إذا كان الإنسان والروبوت سيعيشان في نهاية المطاف جنباً إلى جنب”.
غير أن الجانب الأخلاقي للتجربة الإنسانية لا يزال التحدي الأكبر أمام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي إذا ما أردنا للآلة أن تكون جزءاً أساسياً من حياة البشر. وما زالت السيارات الذاتية القيادة –مثلاً– المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، تقف عاجزة، شأنها في ذلك شأن البشر، أمام معضلات أخلاقية كبرى، كـ “معضلة عربة القطار” الشهيرة التي تضع الفرد أمام خيارين: إما دهس خمسة أشخاص مقيدين إلى سكة قطار حديدية، أو تحويل مسار العربة إلى مسار ثانوي ودهس شخص واحد.
ورغم التطور الهائل الذي تشهده تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي منذ عقدين من الزمن حتى الآن، إلا أنها لم تصل إلى الوقت الذي يتعين فيه على الروبوتات نفسها اتخاذ قرارات أخلاقية، عندها ستواجه هذه التكنولوجيا معضلات أخلاقية شبيهة بمعضلة العربة، ولا بد –حينئذ– من تحديد معايير أخلاقية تعمل الآلة وفقها وتُتخذ مثل هذه القرارات بناء عليها. ظهرت أطروحات مختلفة لحلّ معضلات كهذه، أبرزها موضوع اعتناق الآلة مدرسة أخلاقية معينة من دون غيرها، ولعل مدرستي الأخلاق الوضعية (الكانطية) والأخلاق “العواقبية” هما من أبرز المدارس الأخلاقية وأشهرها في هذا السياق. تحدد المدرسة الكانطية أخلاقية فعل ما من عدمها بالاعتماد على الفعل بعينه من دون النظر إلى حيثياته، فالكذب مثلاً لا أخلاقي مهما كانت الضرورة ومهما كانت النتائج. بينما تحدد المدرسة العواقبية أخلاقية الفعل بالاعتماد على النتائج، فقد يكون الكذب أخلاقيّاً بالنسبة إليها إذا أدى بالنتيجة إلى إنقاذ حياة إنسان. ما يعني أن الجدل مستمر ومثله المخاوف.
في الآونة الأخيرة، تصاعدت هذه المخاوف البشرية من دمج الروبوت أو الآلة في مفاصل الحياة الإنسانية، بخاصة مع إعلان إيلون ماسك، المؤسس والرئيس التنفيذي وكبير المهندسين في SpaceX والرئيس التنفيذي ومهندس المنتجات لشركة “تيسلا” الرائدة في مجال السيارات الكهربائية، عن شريحته الإلكترونية التي لن يقتصر عملها على قراءة البيانات فحسب، بل إدخال معلومات إلى الدماغ البشري، وذلك عبر زرع قطعة (بسماكة 1/20 من سماكة الشعرة) في الدماغ وربطها مع تطبيق على الهاتف الذكي الخاص بالمستخدم.
ورغم تصريح ماسك بأن عمل الشريحة سيكون مقتصراً على مساعدة البشر على القيام بأعمالهم بشكل أكثر سرعة وفعالية، إلا أن التوصل إلى تطوير تقنيات كهذه (لها القدرة على الكشف والسيطرة على معلومات بالغة الخصوصية، بل والتحكم بها أيضاً) يجعل الخشية من سيطرتها على البشر أمراً مبرراً. فتصوَّر مستقبلاً تسيطر فيه الآلة على قطاعات مهنية بالكامل، وتؤدي فيه روبوتات وظائف لطالما كانت تحمل جوانب إنسانية، كالطب الجراحي والتعليم وخدمة الزبائن، وتنشأ به مجتمعات “موازية” على منصات التواصل الاجتماعي، تخزن في قاعدة بياناتها معلومات الأفراد الشخصية وتاريخهم المرضي وحساباتهم البنكية ونشاطهم اليومي، كل ذلك قد يجعل مستقبلاً كهذا يبدو مظلماً في أذهاننا.
بيد أنه، وعلى المقلب الآخر، سيكون لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ذاتها دور عظيم في مساعدتنا على القيام بوظائف حيوية عديدة، كتلك الوظائف الفيزيولوجية التي قد نفقد قدرتنا على القيام بها بفعل مرض أو حادث أو جراء التقدم في العمر، ناهيك بأجهزة مساعدات السمع والأجهزة التي تزرع في جسد الإنسان لتنظيم مستويات السكر في الدم، وغيرها الكثير. ولربما تستطيع “شريحة ماسك” مستقبلاً مساعدة المصابين بأمراض مزمنة كالألزهايمر أو الفصام أو حتى مساعدة الإنسان في التخلص من الاكتئاب. فلطالما كانت الآلة عوناً للبشر منذ وقت طويل، وكانت “امتداداً لنا” في المهن الخطرة والشاقة. وتعد اليوم امتداداً جغرافياً لنا حيث لم يعد محض خيالٍ علميٍ الحديثُ عن إرسال روبوتات إلى المريخ، لتجهيز بنية تحتية وتهيئة بيئة قادرة على استقبالنا كبشر هناك.
وعليه، ورغم تحذير ستيفن هوكينغ من أننا سنكون في مواجهة مع الروبوتات مستقبلاً إذا لم نجد ضوابط لذكائها، دعونا لا نرهَب فكرة استخدام شريحة ذكية أو عدسة أو حتى سيارة تمتلك حرية اختيار مسارها، فلربما يتوصل الإنسان إلى القدرة على منح آلة جامدة خصائص إنسانية لم تزل إلى اليوم ميزة بشرية فريدة، ويبرمج حينها السيارة الذكية المتينة على “الإيثار” لترتطم بالحائط مثلاً وتنقذ الجميع!
 الشرق اليوم اخباري تحليلي
الشرق اليوم اخباري تحليلي