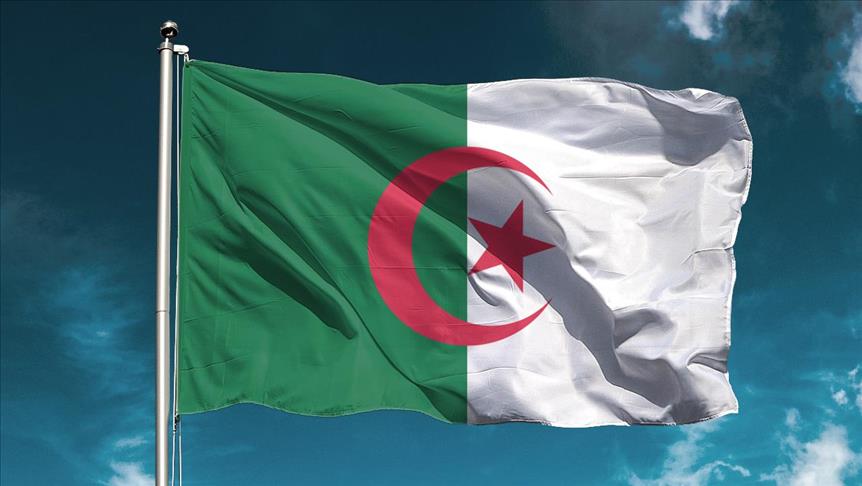بقلم: مصطفى الفقي – اندبندنت عربية
الشرق اليوم – زرت دولة الجزائر مرات عدة، بدأتها بالزيارة الأولى في يونيو (حزيران) 1966 وكنت قد تخرجت من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة قبل ذلك بأسابيع قليلة، حيث فوجئت بالدكتور حسين كامل بهاء الدين، أمين عام منظمة الشباب ووزير التعليم في ما بعد يبلغني بأنه قد وقع الاختيار عليّ لأمثل الشباب المصري في احتفال الجزائر بعيد الاستقلال ونقل رفات الأمير عبد القادر الجزائري من دمشق في سوريا إلى مقبرته في الجزائر كزعيم لثورة الجزائريين ضد الاحتلال الفرنسي.
ولم أكُن قد ركبت طائرة في حياتي وأتذكر أنني أوقفت تاكسي في الشارع أمام منزلنا في مصر الجديدة ومعي حقيبة سفري وقلت له إلى المطار لأنني مسافر إلى الجزائر على خطوط الطيران المصرية. وبالفعل سافرت بالطائرة التي كانت تقطع المسافة إلى الجزائر مباشرة مع توقف لمدة ساعة في مطار إدريس الأول بليبيا، ووصلت إلى العاصمة وكان في استقبالي يومها ممثل الشبيبة الجزائرية واسمه السيد أحمد معراجي الذي أخذني في سيارة رسمية إلى فندق “اليتي” وسط المدينة. وفي المساء، كنت مدعواً إلى الحفل الساهر الذي حضره الرئيس هواري بومدين وكانت مصر ممثلة بشخصيات ثلاث هي السيد محمود رياض، وزير الخارجية آنذاك والدكتور حسن صبري الخولي، الممثل الشخصي للرئيس عبد الناصر وأنا ممثلاً عن منظمة الشباب في مصر.
ولقد تعرفت في هذا الحفل على عدد كبير من الشباب الآتين من دول مختلفة ضمن وفود التهنئة من بلادهم إلى الشعب الجزائري في تلك المناسبة الوطنية الكبرى. وقضيت بعد ذلك يومين في الجزائر أخذت فيهما القطار إلى مدينة قسطنطينة لزيارة عم لي كان أستاذاً في الأزهر الشريف ومعاراً للمركز الإسلامي في تلك المدينة التي تقع شرق البلاد، وقد أتاحت لي رحلة القطار التي استمرت لأكثر من ثماني ساعات أن أختلط بالشعب الجزائري وأتعرف بشكل مباشر على هويته القومية، خصوصاً أننا كنا في الأعوام الأولى بعد الاستقلال والجهود المبذولة من أجل التعريب.
ولقد حضرت لقاءات شبابية أثناء تلك الزيارة ورأيت عن قرب تجربة الشعب الجزائري في بناء كيانه الوطني وأديت صلاة الجمعة في مسجد كبير وعريق في حي القصبة بالجزائر العاصمة.
كانت تلك هي زيارتي الأولى إلى دولة الشهداء والأبطال في الشمال الأفريقي العربي، ومن بين زياراتي الأخرى لذلك البلد العربي شديد المراس، التي كان معظمها في صحبة الرئيس الراحل حسني مبارك، أختار زيارة سرية قمت بها بصحبة الدكتور أسامة الباز حين قرر الرئيس الراحل إيفادنا لزيارة غير معلنة إلى أشقائنا هناك أثناء أعوام القطيعة الدبلوماسية بين مصر ومعظم الدول العربية كرد فعل لتوقيع مصر على اتفاقية السلام في 26 مارس (آذار) 1979.
وقد كانت زيارتنا إلى الجزائر بعدما زرنا الأردن أيضاً والتقينا الملك الراحل الحسين بن طلال في إطار عدد من الزيارات السرية للتشاور حول الأوضاع العربية والفراغ الذي تركه غياب مصر عن الساحة في ذلك الوقت. وقد جرى استقبالنا الدكتور الباز وأنا على نحو لائق وتمت استضافتنا في ما كان يُسمّى بـ”قصر الصنوبر” الذي جرى تشييده استعداداً لاستضافة الجزائر لإحدى قمم عدم الانحياز، وكنا نلتقي يومياً السيد شريف ومساعده أمين عام حزب جبهة التحرير الجزائرية الذي كان يُعتبر الرجل الثاني بعد الرئيس الشاذلي بن جديد.
وظللنا على هذا النحو أسبوعاً نستقبل المسؤولين الجزائريين للتحدث مع الدكتور أسامة الباز بحضوري حول مستقبل العلاقات المصرية العربية والجزائرية تحديداً. وظل الأمر طي الكتمان إلى أن ذهب يودعنا بعض المسؤولين الجزائريين في المطار وعلى رأسهم السيد محمد الأكحل من رئاسة الجمهورية الجزائرية على ما أذكر، ومن ثم كانت المفاجأة ونحن في صالة كبار الزوار حيث وصل وفد فلسطيني رفيع المستوى وتهلل أعضاؤه عند رؤيتنا وأخذوا الدكتور أسامة بالأحضان وبذلك شاع خبر الزيارة التي كنا نتمنى أن تكون غير معلنة، ولكن ما جرى في المطار جعل خبرها يصل إلى وكالات الأنباء حتى عرفها القاصي والداني.
لذلك فإن لي بالجزائر صلة خاصة كأول دولة أزورها في حياتي مستخدماً الطائرة ذهاباً إليها وأتعرف مبكراً على شخصيات منها. وأنا أريد أن أقول في هذه المناسبة إن المغرب العربي بدوله الخمس ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا إنما يمثّل باقة مزهرة في جبين الأمة العربية، لأن تواصلهم مع أوروبا أقرب وانفتاحهم على العالم أكبر، وإذا كنّا نحدّد بمدينة الإسكندرية المصرية معياراً يقول إن كل ما هو شرقها ينتمي إلى حضارة الأرز وما يأتي غربها ينتمي إلى حضارة الكسكس، فذلك يوضح التعددية في المكون العربي في غرب آسيا وشمال أفريقيا ودوره في التأثير في الهوية العربية عموماً وسنلاحظ في دول الشمال الأفريقي أن الإسلام هو دين وقومية بسبب ندرة عدد المسيحيين فيه إلا من كانوا أجانب وافدين عليه باستثناء الجالية اليهودية في المغرب وأعدادها محدودة في تونس والجزائر وربما ليبيا، أما موريتانيا فهي تقف على الطرف الآخر أمام المحيط وكأنها حارس الدين واللغة التي اشتهر أصحابها بالفصاحة شعراً ونثراً، بينما يبقى المغرب دولة مركزية متماسكة يتجذر فيها الإسلام وتوجد فيها العروبة على الرغم من الاعتراف بالثقافة الأمازيغية، لذلك العنصر السكاني القديم في الجزائر وتونس وليبيا، بل إن نسبة من المصريين المقيمين في واحة سيوة وحولها يتحدثون أيضاً الأمازيغية، بخاصة أن الإسلام يجمع الكل واللسان العربي في كل مكان.
وقال بن باديس “شعب الجزائر مسلم، وإلى العروبة ينتسب/ من قال حاد عـن أصله، أو قال مات فقـد كذب”، ولا بد من أن نعترف أن إسهام دول المغرب العربي في الثقافة المعاصرة يتجاوز بكثير ما كان معروفاً منذ عقود عدة، فالجامعات إسلامية ومدنية بدءًا من الزيتونة والقيروان وصولاً إلى الرباط والجزائر وتونس وطرابلس وبنغازي تشكل في النهاية معزوفة حضارية وثقافية تستند إليها الأمة العربية وتفتخر بها شعوب المنطقة.
لقد أثارت زيارتي إلى الجزائر شجوناً قومية في أعماقي وأنا أرقب أحياناً تدهور العلاقات الرسمية بين الجزائر والمغرب على الرغم من أن ما يربطهما من وشائج وصلات هو أقوى بكثير مما يربط غيرهما، وأتطلع معهما إلى يوم تعود فيه الأمور إلى طبيعتها، فالتداخل القبلي والانصهار البشري يجعلان الوضع الحالي استثناءً عن القاعدة التي تجعل المغرب العربي كتلة واحدة في ظل الوحدة الثقافية التي تتمثل في اللهجات والتقاليد والأعراف، ونرنو إلى يوم يستعيد فيه مجلس التعاون المغاربي دوره التاريخي الذي ترقبه مصر في سعادة ورضا لأنها القلب بين جناحين، أحدهما في مجلس التعاون الخليجي والثاني في إطار الاتحاد المغاربي الذي يجب أن يستعيد عافيته في ظل الظروف الإقليمية والدولية على ساحتي الشرق الأوسط والقارة الأفريقية، بخاصة أن معظم دول الشمال الأفريقي تمر بمخاض سياسي محوري في تاريخها، بدءاً من محاولات تسوية الأزمة الليبية، مروراً بالوضع المتميز في تونس والبناء الداخلي في الجزائر والتقدم التقني والاقتصادي في المغرب، واضعين في الاعتبار أن كل المشكلات القائمة والقضايا المعلقة قابلة للحل مهما طال عليها الأمد، فالعروبة تجري في الدماء وروح التحضر والانفتاح في دول الشمال الأفريقي تجعل لها ميزة الجمع بين الثقافتين في جنوب المتوسط وشماله لتبقى ركيزة للمنطقة.
 الشرق اليوم اخباري تحليلي
الشرق اليوم اخباري تحليلي