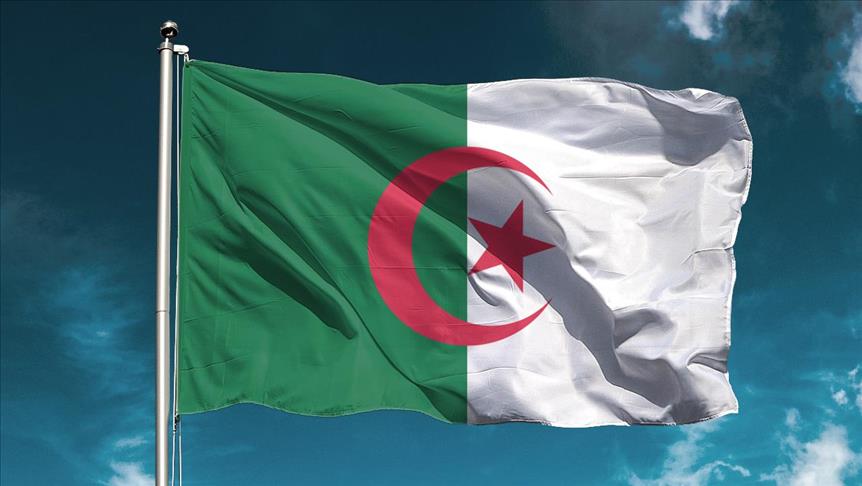بقلم: أزراج عمر – النهار العربي
الشرق اليوم – تواصل أجهزة الحكومة الجزائرية ووسائل الإعلام الموالية لها تهيئة الرأي العام الجزائري للانتخابات البلدية والولائية التي أعلن الرئيس عبدالمجيد تبّون أنها ستجرى في 27 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري بهدف تجديد أعضاء مجالسها بدلاً من تاريخ تشرين الثاني 2022.
وتتحرك أجهزة الحكومة الجزائرية بوتيرة متسارعة لتحضير الأرضية القانونية التي بموجبها تجري هذه الانتخابات في الوقت المحدد لها. ولقد تم تحديد تجديد مجالس 58 ولاية (محافظة) و1541 بلدية وذلك تتويجاً للتقسيم الإداري الجديد الذي أحدثه الرئيس تبون.
وفي بحر هذا الأسبوع تسربت معلومات جديدة تخص المهمات المناطة برؤساء البلديات وأعضاء مجالس المحافظات (الولايات) فضلاً عن مجموعة من القوانين التي لم تعرفها من قبل التشريعات الجزائرية الخاصة بمجالس المحافظات والبلديات، ومنها على وجه الخصوص قوانين تسمح لرؤساء البلديات بالحصول على قروض مصرفية وطنية لتمويل المشاريع البلدية المختلفة، وكذا إقامة شراكات مع بلديات أجنبية على المستوى العربي والأفريقي والآسيوي والأوروبي/ الغربي. ويعني هذا ظاهرياً تحريراً جزئياً للبلديات من التبعية المطلقة للمؤسسات المركزية في الدولة.
وفضلاً عن ذلك فإن القوانين الجديدة التي ينتظر أن تقدم قريباً إلى البرلمان بغرفتيه العليا والسفلى لمناقشتها والمصادقة عليها تسمح للبلديات الجزائرية بأن تقيم العلاقات في ما بينها بما يفيد تبادل الخبرات والعمل المشترك لإنجاز المشاريع المحلية.
ومن الملاحظ أن المشكل الخطير الذي سيواجهه رؤساء البلديات ورؤساء المجالس الولائية يتمثل في ربط كل قرارات هؤلاء بموافقة ممثل الحكومة والمسؤول الأول في المحافظات الجزائرية (الولايات) أو رفضه وهو المدعو في الجزائر بالوالي ما يعني في المنطق السياسي تغليب كفة الإدارة التابعة للحكومة وغير المنتخبة على رؤساء البلديات المنتخبين والمجالس الولائية المنتخبة عبر الوطن.
وفي الواقع فإن هذا القانون الجزائري التقليدي مضر بالعملية الديموقراطية لأن بنود القانون الجديد الخاص بالبلديات والمجالس الولائية ينطوي ضمناً على عدم الثقة بقدرة المنتخبين على رأس البلديات والمجالس الولائية على التسيير الكفؤ والسلس لشؤون المؤسسات والقطاعات الاقتصادية والثقافية والصناعية والاجتماعية التابعة أصلاً للبلديات.
وفي هذا الصدد يرى المراقبون السياسيون الجزائريون أن التشريع الإداري الجزائري لم يفك بعد الارتباط بالموروث الكولونيالي الفرنسي وجراء ذلك فإنه يصر على أن ينسخ حرفياً القانون الفرنسي الذي يجعل من والي الولاية (محافظ المحافظة) السلطة والمرجعية الإدارية العليا في المحافظة.
ورغم أن فسح المجال للبلديات لإقامة الشراكات والتوأمة بمختلف أنواعها المادية والرمزية مع البلديات الأجنبية خطوة مهمة ولكن تقييدها بشرط موافقة المحافظ على ذلك، باعتباره ممثل الدولة، سيجعل مهمة الهيئة المنتخبة على مستوى القاعدة الشعبية شكلية لا تتعدى نطاق المبادرة بالمقترحات التي ستخضع لإرادة ممثل السلطة العليا التابعة لوزارة الداخلية والتي تخضع بدورها لسلطات رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية وأحياناً كثيرة لسلطات أخرى أقوى مثل ممثلي السلطة العسكرية عبر المحافظات.
ويلاحظ أن بعض ما تسرب من قانون البلديات والمجالس الولائية الجديد الذي سيناقش ويصادق عليه قريباً من طرف البرلمان بغرفتيه السفلى والعليا لم يوضح أيضاً طبيعة العلاقة بين رؤساء البلديات والمجالس الشعبية، من جهة) وبين نواب المحافظين الذين يسيطرون على كل السلطات التنفيذية على مستوى الدوائر في كل المحافظات، من جهة أخرى، علماً أن الإبقاء على هذا النمط من التراتبية غير المتكافئة هو مشتق من بقايا النظام الكولونيالي الفرنسي وسيحوّل من دون أدنى شكَ رئيس البلدية أو رئيس المجلس الشعبي الولائي إلى مجرد شخصية محلية هلامية لا تصنع القرار ولا تتحكم في الإدارة المباشرة لأهم القضايا التي تشغل المواطنين.
وفي الحقيقة فإن هذه الاستعدادات للانتخابات البلدية بالذات لم يمهد لها بإعداد ونشر خرائط مصادر الثروات الفلاحية والزراعية والصناعية والحيوانية والثقافية والسياحية في كل بلدية من بلديات الوطن على حدة، فضلاً عن عدم إعداد إحصاءات بأعداد المدارس والمعاهد والثانويات والجامعات وأعداد الطلاب فيها، كما ليس هناك ضبط لعدد العاطلين من العمل ولعدد العمال ولأنواع الوظائف والمهن المتوافرة حتى الآن والمطلوب توفيرها في المدى المنظور وذلك حسب الحاجة المحددة في كل هذه البلديات التي يبلغ عددها بحسب التقسيم الإداري الجديد 1541 بلدية.
وأكثر من ذلك فإن سياسات الدولة الجزائرية منذ الاستقلال حتى الآن تفتقد إلى ضبط مسؤولية كل بلدية في صنع رأسمالها المادي والثقافي والفني الخاص بها سنوياً وبخاصة في مختلف قطاعات الإنتاج الثقافي والفني والصناعات التقليدية والتحويلية، بالإضافة إلى إنتاج ما يكفي سكانها على الأقل من المواد الغذائية التي تمثل جوهر أمنها الغذائي القاعدي ومصير أفقها التنموي.
والغريب في الأمر هو أن البلديات تعوَدت، جراء غياب التخطيط العلمي وإهمال تحديث الأرياف التي تشكل أغلبية مساحة الوطن الزراعية والفلاحي، على استهلاك عائدات ريع النفط والغاز ما جعلها ويجعلها باستمرار عالة على الاقتصاد الوطني النفطي ذي البعد الواحد بدلاً من تحويلها إلى مصدراً للثروات المختلفة التي كانت الجزائر العميقة مسرحاً لها قبل الاحتلال الفرنسي وأثناءه أيضاً.
زيادة على ما تقدم فإن المراقب السياسي يلاحظ أن هذه الاستعدادات للانتخابات البلدية والولائية القادمة قد أقصت الأحزاب المعارضة والشخصيات الثقافية والإعلامية والتربوية من المشاركة الفعلية في إعداد التصورات والخطط العلمية الكفيلة بإخراج البلديات الريفية، التي تمثل الأغلبية في الجغرافيا الجزائرية شبه القارية، من تخلفها البنيوي صناعياً وثقافياً ومعمارياً ومستوى فكرياً وشبكة طرق ومواصلات حديثة وهو السبب المباشر الذي خلق ولا يزال يخلق في الجزائر ظاهرة هجرة أبناء الأرياف إلى المدن بحثاً عن قطرة أمل في حياة أفضل ولكن هؤلاء سرعان ما يساهمون سلبياً في ترييفها وتعميق البطالة فيها.
 الشرق اليوم اخباري تحليلي
الشرق اليوم اخباري تحليلي