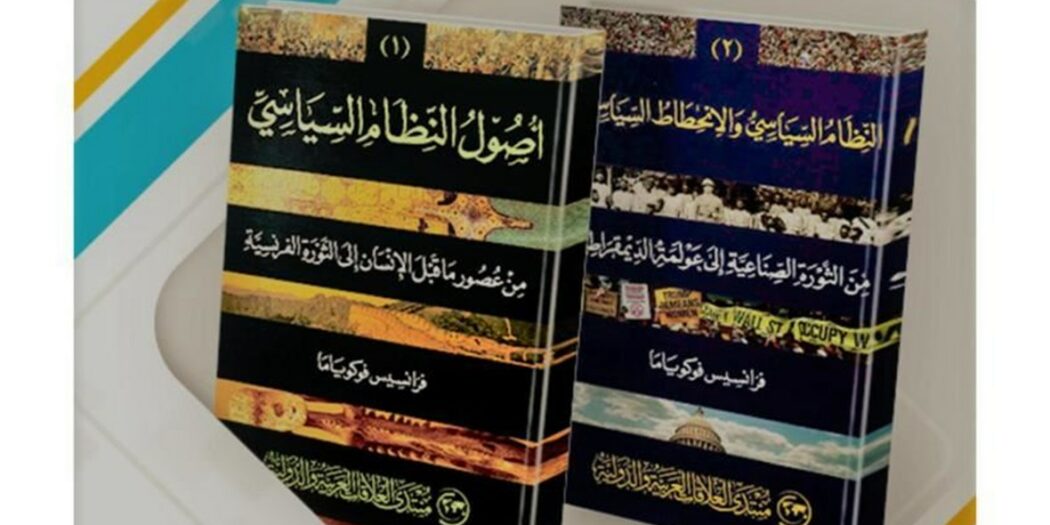بقلم: حسن إسميك – النهار العربي
الشرق اليوم- مضت أعوام عدة منذ أن قرأت كتابَي فرانسيس فوكوياما اللذين يبحث فيهما في “أصول النظام السياسي”، ولم أجد الفرصة أو الوقت الكافي لتقديم مضمونهما. أخيراً نشر المنظّر السياسي الأميركي مقالة جديدة في مجلة “فورن أفيرز” بعنوان “الجائحة والنظام السياسي.. بحاجة لدولة”، يظهر فيها واضحاً تغيّر توجه فوكوياما الفكري. فالباحث الذي اشتهر يوماً لأنه تنبأ بانهيار الاتحاد السوفياتي والمنظومة الشيوعية، والذي قال إن الديموقراطية الليبرالية والرأسمالية الغربية التي لا تلعب فيها الدولة إلا دوراً ضئيلاً في التنظيم والتحكم هي نهاية التاريخ وأرقى ما سيصله التطوّر البشري، يرى اليوم أنه لا غنى عن الدولة في مواجهة الفيروس، وأن استجابة المجتمع المدني مهما كانت كبيرة لن ترقى إلى استجابة الدول، وأن أداء الحكومات سيحمل بالغ الأثر على مستقبل التوزيع العالمي للقوة ما بعد الجائحة.
أعادني موقف فوكوياما هذا إلى كتابيه، فقد تلمست فيهما تغيراً في المواقف منذ ذلك الوقت، ففيهما عاد الكاتب إلى الأصول، علّه يجد الأسباب التي قد تدفع بالنظم الليبرالية الديموقراطية إلى التراجع والنكوص إلى نظم شخصانية أو مستبدة، والتي خطّأت نظريته حول “نهاية التاريخ”.
يمتاز فوكوياما عن غيره من المنظرين السياسيين بأنه يشتغل في السياسة، لذلك لم يفتقد يوماً المرونة التي تسمح له بوضع أفكاره دائماً تحت مجهر المراجعة وإعادة التقييم وحتى التغيير. يبحث أستاذ العلاقات الدولية في جامعة ستانفورد عن نظرية للتطور السياسي بشكل مستقل عن الاقتصاد. وفي سبيل تحقيق ذلك، ناقش أفكاره في مجلدين: أولهما بعنوان (أصول النظام السياسي: من عصور ما قبل الإنسان إلى الثورة الفرنسية) عام 2011، وثانيهما بعنوان (النظام السياسي والانحطاط السياسي: من الثورة الفرنسية إلى عولمة الثقافة) عام 2014.
اعتمد مجلد فوكوياما الأول مصدرين اثنين، أولهما كتاب معلمه صمويل هنتنغتون “النظام السياسي في مجتمعات متغيرة” الصادر عام 1968، وحاجته الماسة إلى التحديث برغم أن المُنظرَين لا يختلفان كثيراً في الآراء، ووصلا تقريباً إلى النتائج ذاتها، إلا أن حوادثَ كبرى تلت نشر كتاب هنتنغتون مثل انهيار المنظومة الشيوعية وصعود دول شرق آسيا كقوة اقتصادية، وانهيار الشيوعية العالمية. أما المصدر الثاني فكان “جملة المشكلات التي تواجهها الدول الضعيفة والفاشلة في بناء هيكليتها على أرض الواقع”. لذلك اتّبع الكاتب المنهج المقارن للوقوف على العوامل التي أدت إلى ظهور نظام سياسي ما في مجتمع دون غيره، مستنداً إلى مواد معرفية تقع خارج تخصصه، بما في ذلك علوم الأنثروبولوجيا والأحياء، وعلم الآثار، ذاكراً خصوصية كل إقليم قام بدراسته من حيث طبيعته الاجتماعية وتموضعه الجغرافي، ليدافع عن وجهة نظره التي ترى أن تطور المجتمعات البشرية يعتمد على صراعها وتكيّفها مع البيئة المحيطة.
يتبع فوكوياما خُطى المعلم الأول أرسطو، فيعدُّ الإنسان كائناً اجتماعياً وسياسياً بطبعه، لذلك نشأت المجتمعات البشرية الأولى اعتماداً على الميل الفطري نحو صلات القربى، ودفع الضرر المحيط بها. وعليه ينتقد الكاتب الاتهامات الموجهة للدين باعتباره أصلاً للعنف والشقاق، بل يعدّه أحد مصادر التماسك الاجتماعي الذي أتاح للبشر آلية التعاون ضمن سياق إنساني أوسع. ومع تطوّر الزراعة في فترات مبكرة، حدث التحوّل الهام من الأسرة إلى القبيلة كوحدة سياسية سبقت ظهور الدولة.
يستند الكاتب الى فكرة هنتغتون القائمة على مبدأ استقلالية عملية التطور السياسي بالكامل عن النمو الاقتصادي والاجتماعي، فجاءت مكوّنات النظام السياسي في مؤسسات ثلاث، هي: الدولة، وحكم القانون، والحكومة الخاضعة للمحاسبة والمساءلة. ومن ثم فإن وجود هذه المؤسسات، أو غياب بعضها، هو ما يميز الدول بعضها عن بعض. لكن وجودها معاً على نحو متوازن هو ما يكوّن الدولة الديموقراطية الليبرالية، كما أسماه فوكوياما (بلوغ الدنمارك).
وفي الحديث عن المؤسسة الأولى في النظام السياسي (الدولة)، يدرس الكاتب بعض الأنماط التاريخية، فيشيد بالدولة الصينية المبكرة التي ضمت العديد من عناصر الدولة الحديثة، باعتبارها نموذجاً سبّاقاً لتطور مؤسسات الحكم التي ظهرت قبل قيام الثورة الفرنسية، ذاكراً في السياق ذاته نظيرها الهندي الذي انحرف مساره بفعل القوة الدينية الحاكمة في البلاد، وتفشي روح القبيلة والقرابة بين الطبقات الحاكمة. أما الدولة الإسلامية التي وضع النبي محمد (عليه الصلاة والسلام) الحجر الأساس لها، فقد تبلور بناؤها بفضل تطوير نظام الرّق العسكري، للخروج من عباءة السيطرة القبلية. بينما لا يخفي الكاتب إعجابه بقصة الدولة الأوروبية التي اتخذت مساراً مختلفاً، حيث تفشت فيها روح الفردية على حساب روح القرابة، بفضل الكنيسة الكاثوليكية التي أضعفت بقوانينها من دون أن تدري، سطوة القبيلة.
وفي الجزء الثالث يعرّف فوكوياما القانون باعتباره القواعد النظرية المجرّدة للعدالة، بل ويذكر أشكال ظهوره وتطوّره في بقاع مختلفة من العالم. فكان أفضل تطبيق للقانون في أوروبا، بفضل خروجها المبكر من القبلية، وتراتبية الكنيسة الكاثوليكية وبيروقراطيتها التي عمدت إلى مأسسة قوانينها بالكامل. أما في الصين القديمة، فقد كان القانون هو ما يأمر به الإمبراطور ويقرره. وبالنسبة الى العالم الإسلامي، فقد تسبّب تدخل المؤسسة الدينية في الحكومة إلى إضعاف سيطرة الدولة، وإضعاف الدور الاجتماعي الذي كان يمارسه العلماء والقضاة. وعليه، يخلص فوكوياما في نهاية هذا الجزء إلى أن حكم القانون لا يعدّ ضرورياً للنمو الاقتصادي، فجمهورية الصين الحديثة لا تتبنى القانون بالمعنى الدستوري، ولكن وجود حقوق ملكية قوية فيها كانت كافية لدعم المعدلات الاستثنائية من النمو الاقتصادي الصيني.
يناقش الكاتب في نهاية المجلد الأول من الكتاب المؤسسة الثالثة من النظام السياسي، وتعني الحكومة الخاضعة للمحاسبة والمساءلة، واعتقاد الحكام بمسؤوليتهم أمام الشعب الذي يحكمونه. وفي سبيل فهم نجاح المؤسسات في مناطق أوروبا، فإنه لا يكتفي بذكر الحالات الناجحة فحسب، بل يعرج على الحالات الفاشلة أيضاً، فيحدد أربعة نماذج لبناء الدولة الأوروبية، هي: الدولة المستبدة الضعيفة (إسبانيا وفرنسا في القرن السادس عشر)، الدولة المستبدة الناجحة (روسيا)، والدولة الأوليغارشية (المجر)، وأخيراً الحكومة الخاضعة للمحاسبة (إنكلترا والدنمارك). ويخصص فصلاً لكل حالة من هذه الحالات، متابعاً بالتفصيل تطور النظام السياسي فيها، ومبرزاً خصوصيتها المحلية.
ويختتم فوكوياما النصف الأول من مؤلفه الضخم بالثورتين الأميركية والفرنسية، على اعتبار أن المبادئ الأساسية للحكومة الحديثة وضعت منذ ذلك الوقت، فلم تعد المهمة بعد ذلك محصورة في العثور على مبادئ جديدة ونظام سياسي أسمى، بل وفي تطبيقها في أجزاء أكبر من العالم أيضاً، وبهذا يمهّد الكاتب للجزء الثاني من مؤلفه تحت ما سماه (الانحطاط السياسي).
حاول الكاتب في الجزء الأول من الكتاب، تقديم قراءة كاملة عن الديموقراطية ونشأتها في العالم، ووصّف تلك الحالة من خلال تقديم بعض التجارب التي عدّ بعضاً منها فاشلاً (دول أفريقيا)، والآخر ناجحاً (أوروبا). كما قدّم مسحاً شاملاً لتاريخ الديموقراطية الخاصة بالولايات المتحدة الأميركية، معلناً ميله الشديد لها، لما تضمّنته من دروس مهمة للبلدان النامية المعاصرة التي تريد إصلاح أنظمتها السياسية، وإنشاء حكومات تستند إلى الجدارة الأهلية. فتطوير حكومة حديثة يرتبط بامتلاكها ما يكفي من القدرة والاستقلالية لأداء وظائفها، مع بقائها مسؤولة أمام المواطنة الديموقراطية وخاضعة لمحاسبتها. وعليه، ينتقد الكاتب الفكرة السائدة عن أن التحديث الاجتماعي – الاقتصادي وظهور طبقة وسطى عنصران كافيان وقادران على إنشاء حكومة حديثة، وذلك لعوامل عدة، أهمها جودة النمو الاقتصادي، وعدم وعي الطبقة الوسطى لمناهضة الإصلاح المناهض “للزبائنية” (نظام المحسوبيات)، كما في حالتي كل من اليونان وإيطاليا.
يبيّن الكاتب من خلال بعض التجارب الواردة في الكتاب، أن بناء الدولة مختلف عن بناء الديموقراطية، إذ هناك أنظمة سياسية ذات أداء فعال وقوي برغم أنها لا تنعم بالديموقراطية بشكلها الصحيح، وعلى النقيض تماماً هناك ديموقراطيات قوية ضمن دول ضعيفة وفاشلة. ومن خلال تتبع المسارات التاريخية للديموقراطية حول العالم، يرى فوكوياما أنها مرت بثلاث مراحل، كانت الأولى خلال القرن التاسع عشر وحتى الحرب العالمية الأولى، والثانية ظهرت عقب الحرب العالمية الثانية، فيما شهدت سبعينات القرن الماضي الموجة الثالثة.
يشبّه الكاتب في الجزء الثالث من الكتاب، حال الدول العربية (في زمن صدور كتابه) بأوروبا القرن التاسع عشر، من حيث عدم وجود خبرة مسبقة بالديموقراطية، وتجذّر عملية التحوّل الديموقراطي في حراك قاده تغيير اقتصادي – اجتماعي بقيادة الطبقات الوسطى. إلا أن التسييس الديني – الإسلام السياسي – الموجود في المنطقة العربية، كان الفارق الأساسي بين التجربتين، ففي أوروبا عُدّت الطبقة والقومية أكثر أهمية من الدين كمصدر للهوية. ومن هنا يستنتج الكاتب أن الطريق ما زال طويلاً أمام الدول العربية لتحقيق التغيير الاجتماعي والسياسي تجاه الديموقراطية.
ولأن ما يميّز المجتمعات بعضها عن الآخر، قائم على عامل المرونة في مواكبة التغيرات واستيعابها، لذا عدّ فوكوياما، كما معلمه هنتغتون، أن “الاستقرار” نقطة ضعف في عملية التطور السياسي التي تمارسها الدول، بل ومؤشر الى انحطاطه. فجوهر الانحطاط يحدث من خلال عمليتين، تتمثل الأولى في الفشل في التكيف مع المتغيرات الطارئة، أما الثانية، فتتمثل في “ميراثية” الأنظمة السياسية فيها، كما يضيف الكاتب عوامل أخرى تساعد على الانحطاط، كالغزو الخارجي، وتغيّر الظروف الاقتصادية أو الاجتماعية وما يتبعها من فساد وتفشٍ لحالة الزبائنية في الإدارة الحاكمة، وهو ما يحدث في دول كثيرة، والولايات المتحدة الأميركية من ضمنها.
وفي ضوء ما سبق، خفّت نظرة فوكوياما التأليهية للسياسة الأميركية مقابل الإعلاء من النموذج الدنماركي، فصار أكثر منطقية في نقده للنموذج الأميركي، إذ إن المشكلات التي تعترض الحكومة الأميركية ناشئة بسبب اختلال التوازن بين قدرة الدولة وكفاءتها من جهة، والمؤسسات المصمَّمة أصلاً لتقييد الدولة وضبطها من جهة أخرى. وهذا يدفعنا للقول: إنّ الدولة الأميركية عادت (ميراثية) في النصف الثاني من القرن العشرين، حتى إنّ ظاهرة (الإيثار المتبادل) مستشرية في واشنطن العاصمة مشكّلةً القناة الرئيسة التي نجحت فئات المصالح في إسناد الحكومة من خلالها.
مع تكامل العناصر الثلاثة المكوّنة للنظام السياسي، تتشكل الديموقراطية الليبرالية الحديثة بطرقٍ عدّة، إذ تحتاج الدول إلى العمل من خلال القانون كي تكون فاعلة ولا شخصيةً. وحين تتوقف الحكومات عن كونها مسؤولةً وخاضعة للمحاسبة تستدعي الرفض السلبي والاحتجاج، وأحياناً الثورة، فلذلك تعدّ المحاسبة حيويةً لأداء الدولة.
وبرأي الكاتب هناك توتر دائم بين المكوّنات الثلاثة للنظام السياسي، فالدول الحديثة تقوم على الخبرة والكفاءة والاستقلالية. ومن جهة مقابلة، تتطلب الديموقراطية السيطرة السياسية على الدولة. وهناك أيضاً توتر بين الدولة العالية الجودة وحكم القانون، فالقانون الرسمي قد يصبح أحياناً عقبةً أمام ممارسة مستوى مناسبٍ من حرية التصرف الإدارية. وهناك توترٌ راسخٌ بين حكم القانون والمحاسبة الديموقراطية.
وأخيراً، يمكن للديموقراطية نفسها أن تكون في حالة توتر مع ذاتها، إذ إن محاولات زيادة مستويات المشاركة والشفافية الديموقراطية قد تؤدي فعلياً إلى تقليص التمثيل الديموقراطي للنظام ككل. وتعني كلّ هذه التوترات (بين العناصر المكوّنة للنظام السياسي) أن كل الأشياء الجيّدة لا تسير بالضرورة معاً، فالديموقراطية الليبرالية الجيدة هي التي تجمع العناصر الثلاثة في نوع من التوازن.
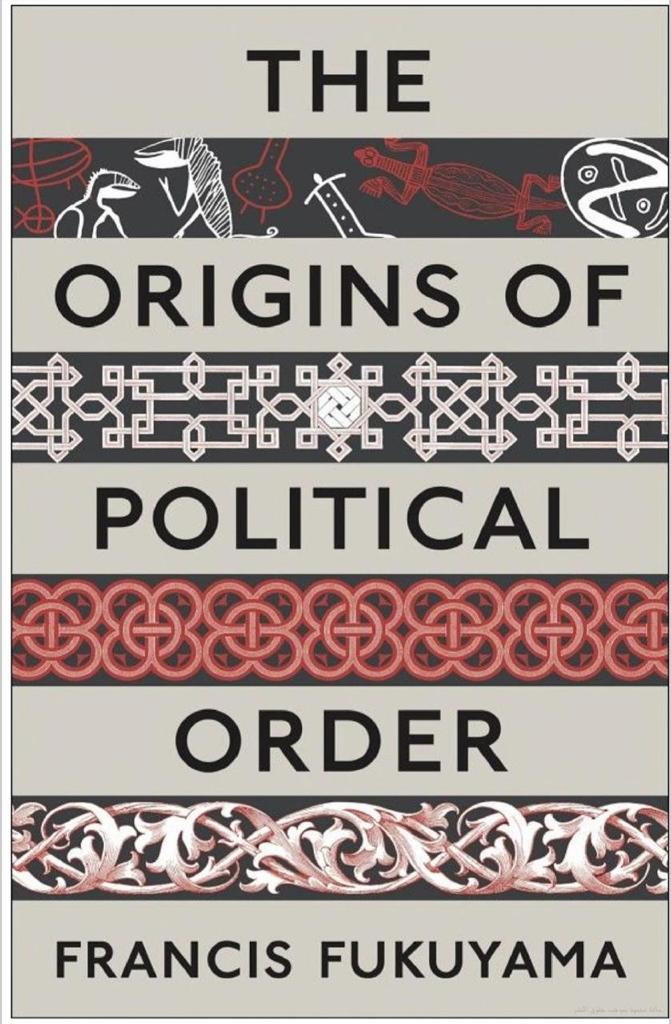
ينبّه الكاتب إلى أن النظام الديموقراطي الليبرالي القائم على المؤسسات الثلاث السالفة الذكر لا يمثل قيمة إنسانية كونية، لأنه لم يتشكّل إلا قبل بضعة قرون فحسب، وهي بمجملها مجرد برهة زمنية في تاريخ النظام السياسي الإنساني. ولكن مع ذلك تشكل الديموقراطية الليبرالية صيغة حكم قابلةً للتطبيق على نحو أعمّ، ويعدّ النظام المتوازن بين الدولة والقانون والمحاسبة شرطاً عاماً للسياسات الحديثة الناجحة، لأنه سيكون من الصعوبة بمكان إدارة مجتمعات كبيرة الحجم يتمتع سكانها بدرجات عالية من التنظيم بغياب قواعدَ قانونية وآلات رسمية للمحاسبة.
يعرض الكاتب في نهاية كتابه بعض النماذج المستقبلية كبديل من الديموقراطية الليبرالية في القرن الحادي والعشرين، فالصين تعدّ التّحدي الأكبر والوحيد لتلك الديموقراطية. وإزاء ذلك، يعلّق فوكوياما حكمه على ما سيصدر عن الطبقة الوسطى الصينية في المستقبل القريب من مواقف تجاه ديكتاتورية نظام الحكم، فإمّا أن ترضى تلك الطبقة بالبقاء تحت وصاية ديكتاتورية الحزب الواحد، وإمّا أن تولّد مطالب بالمشاركة لا يمكن استيعابها ضمن النظام السياسي القائم، وفي الحالة الثانية ستكون الطبقة الوسطى قد تصرفت بطريقة مشابهة لسلوك الطبقة الوسطى في بقية أرجاء العالم.
“كتاب يجب أن يقرأه كل ديموقراطي وكل ديكتاتوري”، هذا ما علّقت به صحيفة “الصنداي تايمز” البريطانية بخصوص مجلدَي فرانسيس فوكوياما عقب صدورهما، ولكن بنظرة شمولية أوسع، يمكن القول: “كتاب يجب أن يقرأه الجميع”. هكذا حقق فوكوياما ـ أحد أشهر المنظرين السياسيين ـ غايته الأساسية برسم نظريته الخاصة عن الأنظمة السياسية. إذ آثر العودة إلى البداية لاكتشاف الجذور، بل وربطها بالنهاية ضمن علاقة “السّبب والنّتيجة”، مانحاً الشرعية التاريخانية لكل الحوادث الماضية والمتعاقبة، والتي شكّلت هذه النهاية عبر نظام الديموقراطية الليبرالية، تلك الديموقراطية التي حظيت بها بعض المجتمعات دون غيرها، بل وجعل منها النموذج الأمثل لما يجب أن يصيره الآخرون العالقون في نهاية الركب.
واليوم.. يبدو جلياً لنا جميعاً أن ساحات واسعة من المنطقة العربية عالقة في مأزق التطور، فهي تتأثر بكل المتغيرات العالمية من دون أن تؤثر، ومن دون أن تحقق خطوة تجاه النهاية التي رسمها الكاتب خلال كتابيه. فقد كان يرى أن الفرصة مواتية بعض الشيء مع انبثاق ما سمي بـ”الربيع العربي” المنتفض على السلطات الحاكمة، والمشابه للفترة التي شهدتها أوروبا عقب الثورة الفرنسية بقيادة الطبقة الوسطى التي تعدّ حامل التغيير السياسي والاجتماعي في كل حركة سياسية ممكنة.
وتبعاً للتطوّرات اللاحقة، وبعد ظهور النتائج المؤسفة التي طفت على السطح، باتت كل الآراء معارضة لذلك الربيع الذي أدخل العالم العربي في فوضى عارمة وقحط مؤلم، معتبرة أن الوضع السابق كان أفضل وأكثر أمناً واستقراراً مما هو عليه الآن. كما لا يمكن إنكار ما آلت إليه الأمور بعد سنوات من الحراك، من تآكل لسلطة القانون ودور المؤسسات المدنية والديموقراطية، على حساب ظهور تنظيمات إسلاموية سياسية ذات أجندات خبيثة كـ”جبهة النصرة” وتنظيم “داعش” والميليشيات الشيعية في العراق أو لبنان واليمن، أو أنظمة حكم إسلامو-سياسية كما في مصر محمد مرسي، أو في ليبيا، فتحطّمت الآمال، وتعطّلت حركة التاريخ العربي، ودخلت المنطقة في سبات من نوع جديد.
إذاً.. برغم دور الدين الحضاري في تطوير المجتمعات في مراحلها الأولى، وهذا ما أقره فوكوياما بوضوح، فإنه سيشكل في حال تسييسه عائقاً كبيراً أمام حركة التاريخ، كونه تحول مصدراً طاغياً على الهويات حول العالم خلال العقدين السابقين. وبحسب مقتضيات المصالح العالمية المتنافسة في المنطقة، أضحت مأسسة الدين الخاصرة الرخوة التي يتم من خلالها تهميش بعض الاعتبارات الإنسانية على حساب أيديولوجية إقصائية وتجهيلية بمعزل عن القانون. وهكذا، يتم إجهاض أي محاولة دفع للأمام من خلال الحشد الذي قامت به بعض المؤسسات الدينية، عقب الصراع المذهبي الدائر في المنطقة والممول ـ مادياً، وعسكرياً، وإعلامياً ـ من الخارج، بهدف تحقيق النسبة الأكبر من مكاسب اللاعبين الكبار على مستوى المصالح الدولية، وتحييد أي محاولات نهوض وتنمية ممكنة.
في الختام…
لم أتوّج الإيجاز في هذا العرض لئلا يأتي على حساب الأفكار المهمة التي يتضمنها الكتابان، فمحاولة فوكوياما من خلالهما البحث عن الصيرورة المناسبة التي تنتهي إلى تشكيل دولة حديثة وقوية تضمن قبل كل شيء كرامة مواطنيها، يجب أن تكون ـ من وجهة نظري ـ الشغل الشاغل لكل المفكرين والسياسيين العرب، خصوصاً في ظل جائحة فيروس كورونا، التي ستغيّر الكثير في العالم، ويكاد الكل يجمع على أن العالم بعد كوفيد-19 لن يكون كما قبله. مثله مثل كل الأزمات الكبرى، والتي غالباً ما تنتج تغييرات جذرية في المجتمعات البشرية على الصعد السياسية والاقتصادية على حد سواء.
تتطلب الأوقات العصيبة اتخاذ قرارات وتدابير جذرية، بخاصة أن أزمتنا العربية جاءت بمعظمها نتيجة أنصاف الحلول، نحن نحتاج اليوم إلى قيادات قوية قادرة على اتخاذ قرارات حاسمة، كما نحتاج إلى الدعم العربي المتبادل والوقوف معاً في صف واحد أمام ما يواجهنا وسيواجهنا من تحديات، من دون استسلام أو ادعاء عجز. يقدّم فوكوياما الدنمارك مثالاً على ما ينبغي أن تكون عليه الدولة الحديثة، ولنا في دول الخليج العربي مثالنا العربي الخاص، لأنها تجعل من دولة الرفاه حلماً ممكناً وغير بعيد التحقيق.
والوصفة ليست صعبة: تحتاج الحكومات العربية أولاً وقبل كل شيء أن تستعيد ثقة مواطنيها، وإيمانهم بقدرتها على الاستجابة الناجحة للتحديات وإيجاد حلول للمشكلات مهما كانت مستعصية. تحتاج منطقتنا بداية إلى السلام والأمن، فمن دونه لا استقرار ولا بناء ولا تنمية. كما علينا أن نركّز على غنى مجتمعاتنا الديني والحضاري كعامل جامع لا مفرّق. وفي النهاية علينا إنهاء كل الحروب التي لا طائل منها في بلادنا، وتحقيق السلام لئلا يدفع جيل الشباب أثمان حرب ليست حربه، ولكي لا يظل الماضي عُصابة تمنعنا من التطلع نحو المستقبل.
يتغير العالم كله من حولنا اليوم، ولم يعد من مصلحتنا نحن العرب أن نقف متفرجين.
*(فرانسيس فوكوياما، أصول النظام السياسي، ترجمة مُجاب الإمام ومعين الإمام، منتدى العلاقات العربية والدولية، ج1 + ج2، 2016)
 الشرق اليوم اخباري تحليلي
الشرق اليوم اخباري تحليلي