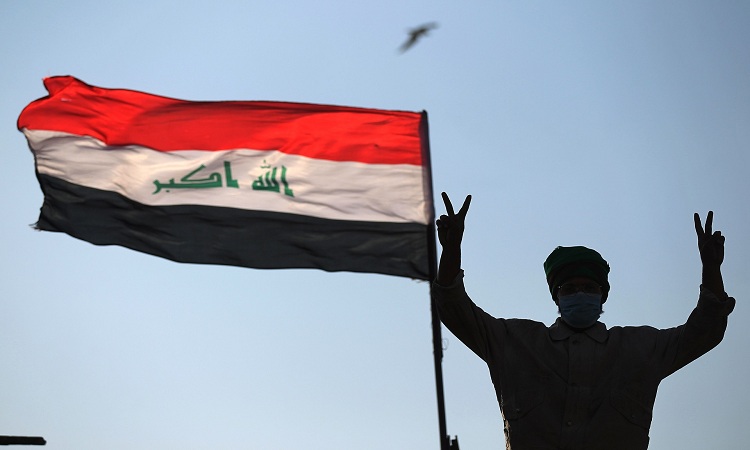بقلم: إياد العنبر
الشرق اليوم- يصف الدكتور علي الوردي اهتمام الشعب العراقي بالسياسة بـ”حدة الوعي السياسي”، وفي الصفحات الأخيرة من كتابه “دراسة في طبيعة المجتمع العراقي”، يقول: “لعلني لا أغالي إن قلت الشعب العراقي في مرحلته الراهنة هو من أكثر شعوب العالم، إن لم يكن أكثرها، ولعا بالسياسة وانهماكا فيها. فكل فرد فيه تقريبا هو رجل سياسة من الطراز الأول. فأنت لا تكاد تتحدث إلى بقال أو عطار حتى تجده يزن لك البضاعة وهو يحاورك بالسياسة أو يسألك عنها. وقد يحمل الحمال لك البضاعة فيحاول في الطريق أن يجرك إلى الحديث في السياسة وهو يزعم أنه لو تسلم مقاليد الأمور لأصلح نظام الحكم بضربة واحدة”.
قبل سبعين عاما، كان ذلك تشخيص العلامة الوردي لتضخم السياسة في حياة المجتمع العراقي، ويمكن وصف هذا الاهتمام بالمفرط (Overload). والذي بات في أيامنا هذه أكثر تضخما وإفراطا؛ وذلك ما تعكسه السجالات السياسية في منصات وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية.
المفارقة، أن مفهوم السياسة في الإدراك الشعبي هو من المفاهيم الملتبسة، وحتى في دراساتنا الأكاديمية لا زالت تعرف بمعان بعيدة عن الممارسة التي تتعلق بمبدأ الدولة الحديثة. فالسياسة في أدبيات العلوم السياسية المعاصرة، ترتبط بمفهوم المصلحة، وعلى أساسها يؤسس العمل السياسي مشروعيته. ومن ثم مفهوم الدولة ووظيفتها يكون في المقام الأول جهاز لإدارة المصالح العامة.
المأزق الحقيقي الذي يواجه مفهوم السياسة، هو انعدام مفهوم المصلحة العامة في ثقافة مجتمعنا، أو أن دلالة مفهوم المصلحة تؤشر معنى سلبيا أو لا أخلاقي! وهنا تكمن إشكالية سوء الفهم التي تنعكس على ممارسة العمل السياسي. في حين عملية الاقتران بين السياسة والمصلحة العامة تشير إلى أن المصلحة المقصودة هنا كل ما يجتمع عليه رأي المواطنين في المجتمع من سيادة حكم القانون، وحفظ السلم والأمن، والرغبة بالحياة الحرّة والكريمة. وهذه المحددات هي المعيار الذي يؤسس للسياسة مشروعيتها، وليس المصلحة الخاصة لمن يدير الشأن السياسي.
ولذلك تكسب السياسة مشروعيتها من أدائها وظائف تحقق المصلحةَ العامة، وهذه هي الغاية الرئيسة من التأكيد على أحقية المجتمع في إدارة الشأن العام، باعتبارها السبيل إلى تحقيق المصلحة العامة التي تجسدها السياسة. وتكون إدارة المصالح المتعارضة والمتناقضة مع المصالح العامة هي مسؤولية الدولة، ولذلك لا يمكن أن نتحدث عن سياسة بهذا المفهوم مالَم تكن لدينا دولة تحكمها المؤسسات وليس توافقات وصفقات المافيات التي تعمل بعناوين سياسية.
في بلد مثل العراق لم يعرف الاستقرار السياسي في العهد الملكي، وتناوب على حكمه العسكر وحزب شمولي وزعيم دكتاتوري، تتحول السياسة فيه إلى فن البقاء بالسلطة من خلال تصفية الخصوم وتحويل الشعب إلى قطيع يتغنى بأمجاد القائد الملهم. وعندما ترسخ السلطة هذا النمط من التفكير، فبالتأكيد لن يتغير فهم المجتمع للسياسة وممارستها من خلال تغير شكل النظام.
وبالتحديد هذه معضلة العراقيين، فبعد سبعة عشر عشر عاما على تغيير النظام، أثبت الواقع أن كل القوى التي كانت تدعي المعارضة لنظام صدام والبعث الشمولي، لم تعارضه من مبدأ معارضة الفكر والنظام الدكتاتوري، بل عارضته لأن الموضوع هو رغبة الحصول على السلطة، وهي اليوم تستخدم أساليب تصفية الخصوم السياسيين، لكن ليس باستخدام سلاح الدولة، وإنما بسلاح الجماعات الموازية للدولة.
تحدد منظومة العمل السياسي في العراق معيار ضعف وقوة التأثير في القرار السياسي وفقا لحجم جمهور الأتباع والمريدين لهذا الكيان أو ذاك، وحجم التمثيل في المؤسسات الرسمية، وقوة السلاح الذي تملكه تلك الجماعات التي تسمي نفسها أحزابا سياسية! ويغيب تماما عن قاموسها مفهوم المصلحة العامة التي تؤسس مشروعية العمل السياسي.
لا يمكن للسياسة أن تجسد مفهوم المصلحة العامة إذا كان العمل فيها وممارستها يجري على أساس تقاسم الحكم وغنائم الدولة بين عناوين سياسية تدعي تمثيلا طائفيا وقوميا، ويهمين على المجال العام فيها جماعات تملك السلاح بطريقة غير شرعية، لأن ذلك سيحول كل فعل وممارسة سياسية لخدمة مصلحة مجموعة معينة، ولا يخدم مصلحة عامة.
ومن ثم لا يستحق هذا النظام صفة السياسي؛ لأنه يخدم مصلحة إقطاعيات حزبية وقومية وعائلية، وتقاسم فيه مؤسسات الدولة ومنافذها الاقتصادية في ظل غياب مستمر للمحاسبة والمسائلة، ليكون في النهاية نموذج للنظام الكليبتوكراسية KLEPTOCRACY “حكم اللصوص”. وهو النظام الذي يسمح بالفساد وسرقة المال العام والخاص من خلال استغلال المناصب الإدارية والسياسية، وهو ما وثقه الصحفي الأميركي، روربت روث، في تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز.
إذا، أضحى كل شيء في مجتمعاتنا يفسر على أنه سياسي! بيد أنه بعيد تماما عن العمل السياسي المرتبط بمفهوم المصلحة العامة. ومن ثم، الإصلاح الحقيقي يبدأ من التثقيف للسياسة بمفهومها المرتبط بالمصلحة العامة، وليس مصلحة الشخصيات ولا الجماعات التي تمارسها عمليا بعناوين التغالب والغنيمة.
وبالتالي تكون شرعية السياسة- كما يحددها المفكر المغربي عبد الإله بلقزيز- فيما تؤديه من وظائف؛ فهي إذ تنصرف إلى خدمة المشترك الاجتماعي العام، وتحاسب على ما أدته أو لم تؤده في هذا الباب، أي تحاسب طبقا لمعيار مطابقتها أو عدم مطابقتها للمصلحة العامة. إنها، في النهاية، تكليف مجتمعي بشري، لا يطلب من الموكلين إليهم أمره سواء أداؤه على النحو المرضي، باحترام الأمانة، التي هي تفويض من المجتمع، واحترام القوانين، التي تمثل تعبيرا عن إرادة المواطنين، على النحو الذي يحصل معه حسن الانجاز، أي تحقيق التطابق بين السياسة وموضوعها (المصلحة العامة).
 الشرق اليوم اخباري تحليلي
الشرق اليوم اخباري تحليلي